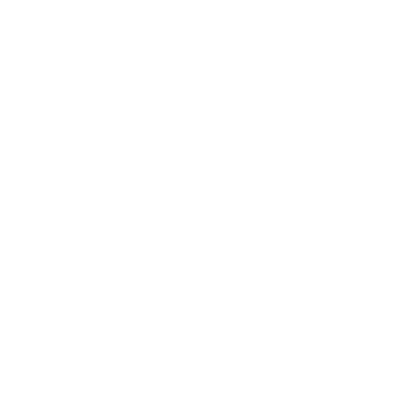لماذا ينكرون محمّدًا (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ (4)

الباحثة: رجاء محمد بيطار
بعدما تمّ الردّ بالحجة والبرهان على أهل الكتاب بكتابهم، وبعدما أوردنا في المقالات الماضية بعض الردود على من ينكرون نبوة محمدٍ صلى الله عليه وآله، سواءً أولئك المنكرين للنبوة أصلًا، أو المنكرين له تحديدًا، وذلك على قاعدة الحديث الشريف "خاطبوا الناس على قدر عقولهم"، وبعدما تمّ إيراد بعض الشواهد التوراتية والإنجيلية على نبوة محمد (ص)، صار لزامًا علينا أن ننتقل للردّ على بعض الشبهات التي طرحها المنكرون قديمًا وحديثًا، حول النبي الكريم وما أتى به من دينٍ وكتاب، ولعل إحدى أبرز تلك الشبهات هو السؤال الآتي:
- كيف يكون محمدٌ نبيًّا بحق، طالما أن الإسلام الذي أتى به هو دين حربٍ وقتال، وقد انتشر بحدّ السيف؟
إن المطلقين لهذه الشبهة عمومًا هم أولئك الذين يدّعون أنهم أهل محبةٍ وسلام، وبالأخصّ الغربيون المقبلون علينا بحضارتهم المادية، التي تحاول جهدها أن تكتسح ما يعترض طريقها بأي سبيل، وهم أيضًا قومٌ من النصارى الذين أرادوا أن يزايدوا على الدين الإسلاميّ بالمحبة والسلام، وأن ينصّبوا أنفسهم حماةً لهاتين القيمتين الإنسانيتين الرفيعتين...
وليس يعنينا هنا أن نفنّد الشبهة بمهاجمة من يفتريها، وبتبيان بطلان أحدوثتهم، حيث أنهم كـ"الطبيب الذي يداوي الناس وهو عليل"، وليس الدليل على كذب هذه المقولة هو أن مطلقها نفسه هو صاحب تكنولوجيا الحروب المتطوّرة التي تهدّد الإنسانية جمعاء، ولا أن النصارى الذين يرفعون اليوم راية المحبة الخالصة هم أحفاد من حملوا الصليب وارتكبوا المجازر باسم المسيح عليه السلام، في الحروب الصليبية القديمة والحديثة، بدءًا بصليبيي القرون الوسطى الذين جيّشوا الجيوش للدفاع عن كنائسهم في الشرق، فلم يتركوا موبقةً إلا افتروها، وانتهاءً بصليبيي القرن العشرين من الصرب الذين فعلوا الأفاعيل بمسلمي البوسنة والهرسك، وغيرهم...
ليس دليل الافتراء أن المفتري نفسه ليس أهلًا ليطلق تهمةً هو نفسه متّهمٌ بها، بل دعونا نحاورهم بالتي هي أحسن، لنظهر بطلان هذه الشبهة بالدليل المباشر والملموس، عسانا نزيح بعض الغشاوة عن عيون المضلَّلين من أبناء أمتنا، الذين يكاد يذهب بدينهم جهلهم بالردّ على هؤلاء المفترين، ووقوفهم عاجزين أمام حججٍ واهيةٍ يتمّ إطلاقها نحوهم بدهاءٍ شيطانيّ، كانسياب الأفعى الملساء التي ظاهرها ناعمٌ وباطنها سمٌّ زعاف...
والجواب هو سؤال، بل مجموعة أسئلة: ما هي أول حربٍ خاضها النبي (ص)؟ ومن كان الداعي إليها؟ وما هو مقياس الحرب والسلم في الإسلام؟ وهل كل حروب المسلمين بعد النبي كانت فعلًا إسلامية؟
والجواب على هذه الأسئلة طبعًا معروفٌ لمن أراد أن يعرفه، فأول حربٍ خاضها النبي بأصحابه كانت معركة بدر، وقد هاجم المشركون المسلمين في بلادهم، وأرادوا إبادة دين الله، فاضطر المسلمون للمواجهة العسكرية الدفاعية، بعدما استنفذ النبي كل وسائله السلمية لدعوتهم إلى دين الحق والهدى على مدى ثلاثة عشر عامًا قضاها في مكة بين ظهرانيهم، وعامين آخرين قضاهما في المدينة المنوّرة مهاجرًا إليها ابتعادًا عن بغيهم وحفاظًا على عقيدته وعقيدة المسلمين الذين اتبعوه، وكان في كلّ تلك الفترة السابقة يدعوهم ويعظهم سلميًّا، ويصبر على أذاهم النفسي والجسدي له ولأتباعه ومناصريه، ولكن دون جدوى، فقد استمرّوا على معاداته وقرّروا أن يستأصلوا شأفة المسلمين ويبيدوهم عن آخرهم، فكانت تلك المعركة الحاسمة؛ معركةً غير متكافئة عددًا وعدّة، ولكن الله نصر عبده، وكانت قواعد الحرب التي سنّها الإسلام في حقّ الأسرى والمنسحبين والشيوخ والنساء والأطفال أكثر إنسانيةً من أي حربٍ أخرى خاضها البشر على مرّ التاريخ، إذ حرّم التمثيل بالقتلى، وحرّم قتل النساء والأطفال، أو قتل من لا يقاتل، ووضع نظامًا لتحرير الأسرى إذ جعل فدية كلٍّ منهم أن يعلّم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة، وعاملهم بالحسنى حتى صار بعضهم يؤمنون بالإسلام قبل تحريرهم، ولم يبقَ متمسّكًا بكفره إلا المعاندين وغلاظ القلوب...
كما أن القرآن الكريم كان صريحًا في توضيح قاعدة الحرب والسلم، إذ جاء في الذكر الحكيم:
﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحبّ المعتدين﴾[1]
إلى آخر ما هناك من حدودٍ وقوانين وأنظمةٍ وضعها الإسلام لينظّم شؤون الحرب والدفاع.
والراصد للحروب التي خاضها النبيّ والأئمة عليهم السلام يلاحظ أنهم لم يبدؤوا يومًا بقتال، وكان الوعظ وتجنّب الحرب دائمًا ديدنهم، فلم يكونوا يقاتلون إلا حين تُفرض عليهم الحرب، فكانت حربهم بالمقاييس العسكرية القديمة والحديثة حربًا دفاعية لا هجومية، وهي حربٌ مبرّرةٌ بكل الاعتبارات الإنسانية، بل إنها حربٌ بطولية، وإننا لنلاحظ كيف تغنّى الغرب ولا يزال بأبطاله الذين دافعوا عن الوطن، فهذا وليام والاس الاسكوتلندي، وهذه جان دارك الفرنسية، وغيرهم كثير، ولكنهم حينما يأتي الدور للإسلام وأبطاله الشرفاء، الذين رفعوا لواء الحق واحترموا حقوق الإنسان، ولم يتجاوزوا أي حدٍّ من حدود الله بأي مقياسٍ كان، ترى المنكرين لهم قد وقفوا ليتشدّقوا بالمفاهيم العريضة التي لم يطبّق أبطالهم منها شيئا...
من ناحيةٍ أخرى، فإن الخلط بين حروب النبي والأئمة، الدفاعية البطولية، وبين الحروب التي خاضها الحكام بعدهم باسم الإسلام، هو أحد الأسباب التي دفعت الجاهلين بالتاريخ للاتهام الذي أعلنوه، أن الإسلام دين حربٍ وفتوحات، وأنه دين حربٍ وسفك دماء...
كما أن التغني الباطل بأبطالٍ إسلاميين ليسوا من الإسلام في شيء، قادوا فتوحاتٍ توسّعيةٍ تحت لواء الإسلام في العصور الأموية والعباسية، كطارق بن زياد وعقبة بن نافع وأمثالهما، هو ما خلط الأوراق وجعل الأمور تبدو على صورةٍ ضبابيةٍ غير متّضحة، فألصق الجاهلون بالتاريخ أفعال ونزوات الحكام الأمويين والعباسيين، الذين كانوا بغالبيتهم مخالفين للإسلام في سلوكهم وحياتهم، وبين الإسلام نفسه، كدينٍ حنيفٍ يدعو إلى كلّ الفضائل الإنسانية، ويحمل همّ سعادة الإنسان الدنيوية والأخروية، ويقوده عبر سلسلةٍ من التشريعات والقوانين إلى كل خيرٍ وعافية... بل إن اسم الإسلام نفسه مشتقٌّ من السلام، وتحيته هي السلام، فلا يعقل بمن "أرسل رحمة للعالمين" أن يكون داعية حربٍ وسفك دماء...
إن هذه التشريعات والقوانين الإلهية التي رسمت خطّ السعادة للبشرية، كانت هي نفسها أيضًا محطّ استنكارٍ من قبل المنكرين، الذين أرادوا أن يشكّكوا المسلمين من جهة، في صوابية دينهم ونبيّهم، والعالمَ من جهةٍ أخرى، في أحقية الدين الإسلامي ورسوله الكريم، وذلك ليدفعوا عن أنفسهم وعن حضاراتهم المظلمة الموبوءة هذا النور المبين، الذي سيتمه الله ولو كره المبطلون...
وتبقى مناقشة هذه النقاط، والإجابة على بعض الشبهات حول التشريعات التي جاء بها النبي (ص) عبر رسالته السمحاء، محور مقالتنا المقبلة بإذن الله، فنسأل الله أن يوفقنا لذلك، وأن يجعلنا ممن ينتصر به لدينه، إنه قريبٌ مجيب.
[1] سورة البقرة، الآية 190