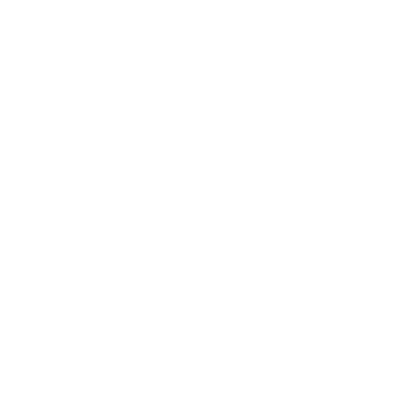الخارجون عن النسق: ماكسيم رودنسون... الوقوع في جاذبية الإسلام

د. هاشم الموسوي
نشأ الاستشراق الحديث مع القرن التاسع عشر، وهو القرن الذي توسعت فيه حملات الغزو الاستعماري التي قامت بها الأساطيل الأوربية التي عبرت البحار بحثا عن المواد الخام والطاقة والذهب والمعادن الثمينة لإدامة المصانع والمعامل التي ظهرت بأوربا بعد حركة تصنيع كان من نتائجها المباشرة الحاجة الى الغزو والاستعمار وتركيع الشعوب الأخرى بهدف سلب خيراتها.
ولذا كانت الحاجة الى الاستشراق بوصفه نشاطاً يدرس الشرق وأحواله ويقوم به مجموعة من المتخصصين حاجة ملحة لمرافقة متطلبات الآلة الاستعمارية ولتقديم يد العون لها أو حتى للتمهيد لها قبل عملية الاحتلال ذاتها.
ومن المعروف أن المستشرقين الغربيين قد اهتموا كثيرا في دراسة الشرق والاحاطة في تفاصيله كافة، وباتت دراسات الاستشراق من الأهمية بحيث أضحت مراجع معلوماتية مهمة حتى للمسلمين وللشرقيين من غير المسلمين لما لها من الاهمية والندرة والإحاطة، وبالرغم من أن من بين هذه الدراسات المزيف المشبوه المكتوب بنيّة مغرِضة، ولكن منه الجاد النزيه ذي النزعة العلمية الواضحة، ومنها الصادق الذي يعد وثيقة صريحة للدراسات غير المتحيزة التي كتبها غير المسلمين عن المسلمين أنفسهم.
ولعل ما يجعل هذا اللون من النشاط الاستشراقي المرتبط بالاستعمار مذموماً في الثقافة العربية المعاصرة وإن قدم الكثير من المعارف إلى الثقافة العربية بتحقيق التراث وبتوظيف مناهج العلوم الحديثة على أغلب العلوم الكلاسيكية التي عرفها العرب دون تطوير وإضافة إلى ما قدمه القدماء، هو لأنه خدمَ الآلة الحربية الغازية وسعى إلى تسويق برامجها وثقافتها الاستعلائية في الوقت الذي كان عليه أن يفعل العكس، انطلاقاً من أن المعرفة يجب ان لا تبتعد عن همومها الإنسانية العذبة.
ولا يشذّ في هذه القاعدة الاستشراق الفرنسي عن غيره من أصناف الاستشراق الأوربي التي رافقت الآلة الحربية الاستعمارية، فالاستشراق الفرنسي يعدّ من أكثر أنواع الاستشراق اهتماماً بالثقافة العربية وبالاسلام وبنشأته وبنبيّه الكريم وبسيرته، وذلك بسبب الاحتلال المبكر الذي قام به نابليون لمصر، وما ترتب عليه من احتكاك ثقافي بين المسلمين والفرنسيين الذين يعدون الى جانب ذلك من أقرب الأوربيين جغرافياً على المسلمين بعد الاسبان، ولذلك انقسم المستشرقون الفرنسيون الى قسمين منهم المتحامل على الاسلام، ومنهم المنصف، الذي يرى الأمور بعين الدارس الموضوعي لا بعين المستعمر المحتل.
ولعل المستشرق اليهودي (ماكسيم رودنسون 1915-2004م) واحد من أكثر المستشرقين الفرنسيين كتابة عن الإسلام ونشأته ونبيّه الأكرم، وكل ما يتعلق بعلاقته بالأديان الأخرى، ولا سيما في علاقته مع المسيحية وتأتي اهمية كتبه ودراساته التي كتبها من خلال زمنها المرتبط بتخلص البلدان الاسلامية من ربقة الاحتلال مما يجعلها عينة صالحة للغرب في ضرورة اعادة علاقته مع الاسلام والمسلمين على مبدأ الاحترام المتبادل وعلى ضرورة وضع المسلمين ضمن حجمهم الحقيقي فهم من بين الملل القليلة التي لم تتفاعل مع المستعمرين ولم تعاملهم على انهم فاتحون بل على انهم غزاة يجب مقاومة وجودهم وطردهم عن ديار الاسلام.
وقد كتب (رودنسون) مجموعة من الكتب من اهمها (محمد) وكتاب الاسلام والرأسمالية وكتاب الاسلام سياسة وعقيدة وكتابه الاهم (جاذبية الاسلام) الذي ابتدأه بحديث طويل عن طبيعة الصورة غير المنصفة التي رسمها القساوسة القدامى للإسلام والتي بقيت صورة مؤثرة بالذهنية الأوربية حتى العصور الحديثة، وكانت هذه الصورة تقوم على تصوير المسلمين كالبرابرة المتوحشين الذين تقع تحت أيديهم أراضي خصبة شاسعة فيها الكثير من الخيرات الوفيرة، وكانت أشد هذه الصور التي رسمها قساوسة روما ظلماً وتجنياً هي تلك التي وسموا بها نبي الإسلام الذي وصفوه بالساحر الذي استطاع أن يحطم كنائس أفريقيا وآسيا دون أن يتصدى له أحد.
غير أن هذه الصورة النشاز المرسومة عن الاسلام كانت تتناقض مع ما يُترجم من كتب عن الحضارة الاسلامية الى اللغات الاوربية وكان الدارسون الاوربيون في القرون الوسطى يجدون أنفسهم في حيرة من هذا الامر كما يرى رودنسون، وكان القساوسة يفسرون ذلك لطلبة العلم بأن المسلمين الذين يكتبون هذه الكتب هم على خلاف كبير مع الاسلام ومع نبيه، وهذا أمر مضحك للغاية!
وكان هذا الأمر يزداد تعقيداً عندما كان التجار المسلمون الموصوفون بالأمانة والصدق وحسن المعاملة يعكسون للناس الذين يتعاملون معهم صورة تناقض الصورة التي رسمها القساوسة عن المسلمين، والتي أصبحت تتآكل بمرور الزمن بعد أن غلب عليها طابع التزييف والكذب، وكان على الرهبان والقساوسة أن يجدوا بدائل لمواجهة الإسلام، وكان الالتفاف حول الاسلام من أسهل الطرق للمواجهة، وهو ما حدث بالفعل عندما تحالف قساوسة أوربا ورهبانها مع المغول الذي بدأ بالنشاط كقوة عظمى في أواسط آسيا مع بداية القرن الثالث عشر الميلادي, لكن هذا التحالف فشل بسب عدم الثقة المتبادلة بين الأوربيين والمغول الذين اعتنق أغلبهم الاسلام بعد سقوط بغداد، فصاروا يشكلون عبئاً آخر على أوربا يضاف إلى عبء المسلمين.
ولكن الصفعة الحقيقية التي نبهت أوربا على الخطر الإسلامي - كما يرى رودنسون - كانت مع بداية القرن الرابع عشر مع بزوغ نجم الدولة العثمانية واحتلالهم للعاصمة البيزنطينية التي ظلت صامدة منذ بداية الفتح الإسلامي وحتى 1450م التي كانت دافعاً إلى ترجمة القرآن لمعرفة حقيقته التي هو عليها، فضلا عن لغته التي أنزل بها، وهكذا بدأت مع العام 1492م بدافع أيديولوجي بحت الدراسات العربية ثم في روما وباريس التي أنشأت عام 1539م أول كرسي للغة العربية، وهكذا الحال مع بقية المدن الأوربية التي بدأت بجمع المخطوطات وكل ماله علاقة بالقرآن من مختلف المدن والامصار الإسلامية.
وينتهي رودنسون بخصوص ما ينطوي عليه الاسلام من عمق حضاري وإنساني ومن قابليات على إقناع المتشككين ومن يقفون ضد فكرة التدين أصلاً إلى أمرين هما: إما قبوله والإيمان به كدين سماوي يتطلب عند الحديث عنه في المؤسسات المعرفية الأوربية العدل والإنصاف، وإنَّ هناك في مقابل هؤلاء تقف شريحة واسعة من الإسلام - مع إعجابهم به وانبهارهم بقيمه وتأثيره وجاذبيته - موقفًا عدائيًّا، يتمثل في التحريض عليه، ومهاجمته، وتشويه صورته في الغرب، يدفعهم ليس التحامل وعدم الإنصاف والعدل فقط، بل الغيرة والحسد، كما يذهب هذا المستشرق المخلص للحقيقة العلميّة.
أو أن يصبح الإسلام يمثل تهديداً لأسلوب ونمط الحياة بالنسبة للغربيين، إذ بدأت مخاوف الأوربيين منذ سنوات عندما استبدلوا بعض منهم دينهم، وصاروا مسلمين، كما أذيعت حكايات عن قيام بعض قادة الفكر، وبعض النخب في الغرب باعتناق الإسلام.
إن هناك رد فعلٍ شديدٍ يشبه الهلع من الإسلام، بسبب ما يتصف به هذا الدِّين من التماسك والاستقامة والثبات والحيوية، وهذا ما يفتقر له الغربيون، كذلك توجد تناقض وازدواجية تجاه الإسلام، سببهُ ليس التحامل والتحيز فقط، وإنَّما الحسد والغيرة من أشياء لدى المسلمين، لم يعد لها وجود في الغرب، ذلك هو الإيمان الراسخ بمعتقدهم وأيدلوجيتهم.