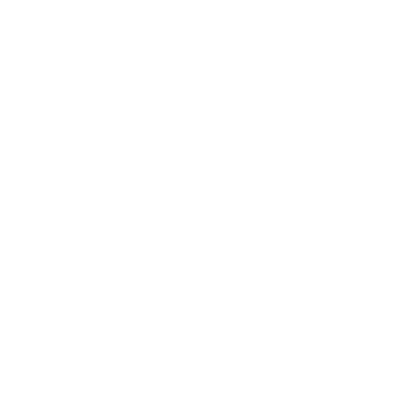في مدرسة كربلاء

الشيخ إبراهيم أحمد الميلاد
الصورة: خضير فضالة
إنما كانت كربلاء في تاريخ هذه الأمة لتبقى مدرسة خالدة للأجيال تلهمها روح الجهاد والممانعة في وجه كلّ انحراف وظلم، وتفتح لها آفاقاً واسعة ورحبة في فهم الدين والحياة بعيداً عن الأهواء المتضاربة والآراء المتصارعة.
ولا يخفى على المتتبع لحوادثها وتداعياتها ما تنطوي عليه هذه المدرسة من دروس وعبر حتى غدتْ منهلاً للثوار ومشعلاً للأحرار يتفيؤون ظلالها ويستضيئون بنور هديها في منعطفات الحياة وبين يدي تحدياتها الكبرى. ولكن، ماذا ينبغي أن تتعلمه أمتنا اليوم من دروس عاشوراء وكربلاء الإمام الحسين عليه السلام على ضوء ما تعيشه من حاجات مستجدة وتحديات متجددة تلف حياتها وتكاد أن تهيمن على واقعها برمته؟!
إذا كانت «كربلاء» الدم والشهادة على طول تاريخ هذه الأمة وأجيالها هي المرجع، وعليها المعول بالنسبة لكلّ الثوار والأحرار والمصلحين، حيث يستلهمون منها الروح المتوثبة للحق والحرية والعدالة، فإن أمتنا -وجيلنا المعاصر بالتحديد- بأمس الحاجة إلى أن يتعلم من كربلاء الحقائق والقيم التالية:
الإصلاح فريضة
ليست كربلاء في جوهرها وأهدافها البعيدة إلا مشروعاً إصلاحياً قد وقف بكلّ عزيمة وحزم في وجه الطغيان الأموي الذي جعل من «مال الله دُولاً، ومن عباده خَولاً» ولم يرضَ بكلّ ذلك حتى أصرَّ على أن يجعل «يزيد بن معاوية» خليفة على المسلمين وهو «رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة» لا يملك شيئاً من مؤهلات الخلافة والإمارة، فما كان من الإمام الحسين عليه السلام إلا الوقوف في وجه المؤامرة الأموية الجديدة برفض البيعة مطلقاً وكشف حقيقة «الشجرة الملعونة في القرآن» وإن الخلافة محرمة على آل بني سفيان بالنص النبوي الجلي وبالتالي «مثلي لا يبايع مثله» و«على الأمة السلام إذا ولي يزيد أمور هذه الأمة» وهو معنى قوله «وأني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي عليه السلام أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر..» .ولأن الإمام عليه السلام في عقيدته هو أولى من غيَّر - كما قال هو -، لذلك كان منه القيام في وجه الظلم الأموي والاستهتار اليزيدي بشؤون الدين وأمور المسلمين.
وهو أحد تلك الدروس التي على كلّ جيل ولاسيما جيلنا المعاصر أن يُحسن فهمها ويعي دلائلها وهو يعيش مختلف ألوان وأشكال الظلم والعدوان على دينه وحريته ومقدساته. فكيف ينبغي أن يكون الموقف وكيف ينبغي أن يكون التصدي والمواجهة لكلّ ذلك؟
إن «الظلم ظلمات يوم القيامة»، وأن «الساكت عن الحقّ شيطان أخرس»، ولقد رأينا ما قد قدمه الإمام عليه السلام وأهل بيته وأصحابه من الرجال والنساء والأطفال من تضحيات قلَّ مثيلها، بل لا مثيل لها «لا يوم كيومك يا أبا عبد الله» دفاعاً عن الحقّ المغصوب ودين الله الذي قد لبسه الأمويون لبس الفرو مقلوباً! ونصرة لكلّ الذين نالهم الظلم الأموي والجور اليزيدي، فكان ما كان من أمر قيامه عليه السلام ومطالبته بالإصلاح وتقديمه كلّ ما يملك حفظاً للدين وصوناً لشريعة سيد المرسلين عليه السلام ودفاعاً عن كلّ مظلوم ومقهور. «ألا ترون إلى الحقّ لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء ربه محقاً» فهل تعي أمتنا وجيلنا هذا المنطلق الذي انبثقت منه شرارة كربلاء فتحولت إلى إعصار من نار أحرق العرش الأموي ودمر كبرياءهم وجبروتهم؟!
الانتصار للقيم
كربلاء هي تلك القيم الإلهية التي بشَّرت بها الأديان السماوية والشرائع الربانية وأكملها دين الإسلام وأتمها القرآن. «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» «أخلاقه القرآن» «حسين مني وأنا من حسين» ، وقد تجسدت تلك القيم والفضائل في رجال كربلاء والمشاركين فيها كلّ بحسب قابلياته واستعداداته وتجلَّت في أقوالهم «الخطب - الرجز - الشعر - المواعظ» وكذا كشفت عنها في أروع المواقف أفعالهم حتى قال فيهم الإمام عليه السلام: «فإني لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي، ولا أهل بيت أبرّ ولا أوصل من أهل بيتي» ، ولاشك في أن تلك القيم والمبادئ كالحق والحرية والعدالة والإيثار والتضحية والعطاء وغيرها كثير هي التي انتصرت في تلك المواجهة الدامية على الرغم من أن معسكر الإمام الحسين عليه السلام قد قتل رجاله ولم يبقَ منهم أحد! بل وقطعت رؤوسهم وعلقت على أسنة الرماح... لكن تلك السيوف التي كانت تقطر حقداً وكراهية لآل بيت الرسول عليه السلام «نقاتلك بغضاً منا لأبيك» وتلك الرماح والنبال السوداء بالضغينة لم تتمكن أن تصل إلى تلك القيم وأن تنال منها حتى بمقدار «الخدش» وبقيت في مكانها الأعلى كما شاءت لها السماء حية فاعلة متألقة تنال من الأعداء وتأخذ منهم كلّ مأخذ حتى كشفتهم على حقيقتهم وأظهرت المكنون من نفاقهم والمستور من نياتهم السوداء في مقاتلة الصفوة من آل الرسول عليه السلام ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ فهؤلاء الأبرار الأحرار قد نالوا بشهادتهم بين يدي ابن بنت نبيهم عليه السلام الحياة الخالدة والبقاء الأبدي وتحولوا إلى عناوين مشرقة متوهجة تشير إلى تلك القيم الإلهية التي ستبقى إلى الأبد تزين حياة الإنسانية بألوان الحرية وأطياف الكرامة ومشاعل الحق والعدالة.
وما أحوج البشرية فضلاً عن عموم المسلمين وخصوص الموالين والمحبين إلى أن يتعرفوا على تلك القيم الحسينية الكربلائية العاشورية، وأن يرتقوا بأرواحهم إلى مستوى ما تتسنمه من قمم الفخر والشَّمَم لعلهم يتمكنون -اليوم بالذات- أن يعوا ذواتهم ويعرفوا ما حولهم، وبالتالي مواضعَ أقدامهم في عالم تزدحم فيه قيم المادة وتطغى عليه نوازع الشر. إن وراء كلّ مقولة وفعل وموقف في مدرسة كربلاء قيمة عليا وفضيلة مثلى ينبغي التعرف عليها والالتزام بها والسير على هديها في دروب الحياة ومنعطفاتها وأمام تحدياتها المتجددة.
لا مواجهة بلا إعداد
المواجهة بين الحق والباطل من ثوابت الحياة وسننها الحتمية لاستحالة اجتماعهما وارتفاعهما كما هو معلوم بالبديهة، ولكن لا يكفي من الناحية العملية لغلبة الحق على الباطل كونُ الأول حقاً والثاني باطلاً بل طبقاً لقانون السببية العام ينبغي الإعداد لكلّ معركة في كلّ مواجهة بينهما - إعداداً موضوعياً لا يتجاهل شيئاً من الشروط اللازمة للانتصار في أي معركة تاريخية تجري على الأرض- وهذا ما نراه جلياً ومما ينبغي أن تتعلمه الأمة والأجيال في مدرسة كربلاء الخالدة، فإلى جانب معرفة الإمام الحسين عليه السلام ومن كان معه من أهل بيته وأنصاره بما هو تكليفهم الشرعي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالتالي رفض البيعة وعدم القبول بها، وبالرغم من معرفته عليه السلام وتعريفه لهم بما ستؤول إليه الأمور على أرض كربلاء في اليوم العاشر من المحرم إلا أنه عليه السلام لم يألُ جهداً ولم يذخر رأياً ولا خبرة إلا واعتمدها في التخطيط لنهضته الإلهية والإعداد الدقيق لكلّ ما يمكن أن يقف أمامها أو يعترض طريقها فلم يكن ثمة ما يمكن أن يتفاجأ به في نهضته المقدسة وذلك من لحظة بلوغه نبأ هلاك معاوية وإلى آخر رمق من حياته الشريفة مروراً بتواجده في مكة طيلة المدة المناسبة واستقباله لكتب أهل الكوفة وتكليفه لابن عمه مسلماً باستعلام نياتهم وعدم القطع بأمر دون مراجعته وطريقة استقباله وحواره للجيش الذي كان على إمرته «الحر الرياحي» «اسقوا القوم، وارووهم من الماء، ورشفوا الخيل ترشيفاً» وكذا ما كان منه عليه السلام من أمر تواجده على أرض كربلاء واتخاذ كافة التدابير الاحترازية ليلاً وقبل نشوب المعركة واصطدام الجيشين حيث جمع الخيام وحفر الخندق وأضرمه ناراً قبيل المعركة وحيث نظم أصحابه أفضلَ تنظيم و أوصاهم بكلّ ما ينبغي أن يكونوا عليه من إيمان وثبات وشجاعة كما أوصى عقيلة بني هاشم عليه السلام ومن حولها من النساء والأطفال بما ينبغي أن يكونوا عليه من استعداد ويقين وتسليم وصبر وأن الله حافظهم مهما تعاظمت عليهم المصائب كما حدد لهم وظيفتهم ورسم لهم ما ينتظرهم من أدوار وهم في ركب السبايا وهكذا أسرَّ لابنه زين العابدين عليه السلام ما يهمه من أمر الإمامة والأمة...
وبالنتيجة، فإن المتتبع لدقائق نهضته المباركة يرى بأنه ليس من شيء إلا وكان للإمام عليه السلام فيه نظر واضح وخطة متكاملة، وهذا لعمري من أعظم ما تزخر به المدرسة الكربلائية من دروس وعبر في الإصلاح والتغيير، وهو ما ينبغي أن تلتفت إليه وتتعلمه الأمة وأجيالها المتلاحقة في مختلف مجالات حياتها ولاسيما في مواجهتها الحضارية العامة.
مسؤولية الإصلاح شاملة
من يتأمل كربلاء فيما كانت عليه ممن قد قام بها وشارك فيها وساهم يلاحظ التنوع الرائع الذي شكل جبهتها، وكان عماد معسكرها من الرجال والنساء والأطفال وهم من أمصار متعددة وقبائل وعشائر متنوعة وهو النسيج الذي تفاعلت عناصره روحياً وعملياً على صعيد واحد وفي زمن واحد وفي وجه عدو واحد حتى تمكن من أن يسطر ملحمة لا أروع منها في البطولة والتضحية والفداء من أجل الله والحق والحرية والعدالة فكانوا بذلك شهداء العقيدة والفضيلة بكلّ ما تحمله هذه الكلمات من معان سامية، فإلى جانب قائدها الفذ العظيم سيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله عليه السلام وسبطه وهو من أعرق البيوت وأشرفها نسباً وحسباً ومن حوله أقمار بني هاشم ممن بلغوا الذروة في الطهر والنزاهة وصفات الكمال كأخيه العباس وابنه علي الأكبر وابن أخيه القاسم عليه السلام أقول: إلى جانب هؤلاء «الحسين وأهل بيته عليه السلام »، تجد في كربلاء «الأصحاب» ممن اقتحموا العقبة ونالوا شرف القتال والشهادة بين يدي إمام زمانهم كحبيب الصحابي الفقيه والمجاهد الكوفي وجون مولى أبي ذر وهو عبد أسود كان في ضيافة بيت الإمام عليه السلام وخدمته و «برير بن خضير الهمداني، وكان شيخاً تابعياً ناسكاً» و«عابس بن أبي شبيب الشاكري، وكان رئيساً شجاعاً خطيباً ناسكاً متهجّداً» و «أبو ثمامة عمرو بن عبد الله الصائدي، وكان تابعياً ومن فرسان العرب ووجوهها» و أنس بن الحارث الكاهلي الأسدي وهو صحابي كبير السن شهد بدراً وحنيناً بكى له الإمام الحسين عليه السلام لما رآه وقد برز إلى القتال لما كان عليه من هيئة وغيرهم من الأخيار كزهير بن القين ومسلم بن عوسجة ممن قدموا أنفسهم قرابين لله تعالى بين يدي إمامهم الحسين عليه السلام فنالوا بذلك شرف الدين والدنيا، وإلى جانبهم كن النساء المخدَّرات من بنات علي وفاطمة عليه السلام من بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ومعهن لفيف من نساء بعض الرجال ممن التحقوا بالإمام عليه السلام وكانوا معه.. هذا بالإضافة إلى الأطفال من البنات والبنين ممن تفاوتت أعمارهم ولقد كان لهم جميعاً نصيب وافر مما تُدمى له القلوب من المعاناة والألم مما قد لحقهم في كربلاء وبعدها في السبي.
وأنت إذا ما تأملت هذا النسيج الطيفي المتنوع وما قد قدمه للدين والأمة والإنسانية من دروس وعبر انكشفت لك الحقيقة الدينية الكبرى في أن مسؤولية الإصلاح والتغيير ليس حكراً على شخص أو جهة وإنما هي شاملة لكل من يتوقف على حضوره ومشاركته وتضحيته الدفاعُ الكامل عن الدين والمقدسات وحفظ الأعراض والنفوس والحقوق من أن تنتهك أو يتلاعب بها الطغاة الحاكمون أو أصحاب النفوذ والمصالح الرخيصة وهو ما ينبغي على الأمة بكلّ أجيالها وشرائحها وفئاتها وطبقاتها أن تعيه بعمق وأن ترتب عليه الآثار العملية في نظرتها لواقعها المعاش والموقف منه والتصدي إلى إصلاحه وتغييره بكلّ الوسائل المشروعة والفاعلة وكلّ بحسب قدرته المتاحة وإمكانياته المتوفرة فليس ثمة من هو في حِلٍّ من مسؤولية التصدي للإصلاح والتغيير ما دام أمر الأمة على ما هو عليه وحاجته الماسة لكلّ جهد وسعي ليتغير وليتحول نحو الأفضل دينياً وحضارياً «فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» كما أسس لذلك نبي الإسلام في هذا المأثور من الخبر المشهور.
ما لله ينمو
يكفي للتدليل على كون كربلاء في كلّ ما كانت عليه من أهداف ومنطلقات ووسائل لله - تعالى- وخالصة لوجهه الكريم الالتفاتُ إلى حقيقة ما هو عليه الإمام الحسين عليه السلام من عصمة وتسديد وتأييد إلهي! «ومثلي لا يبايع مثله» ،وعلى الرغم من سلامة هذا «المسلك العقائدي» في التدليل على هذا المعنى إلا أن ثمة مسلكاً آخر «تاريخي» هو أقرب في طبيعته لما هو مألوف لدى أغلب الناس في فهم الأمور والتدليل عليها ألا وهو جمع القرائن والتأليف بينها للوصول إلى إثبات هكذا مطالب هي في منتهى الخفاء.