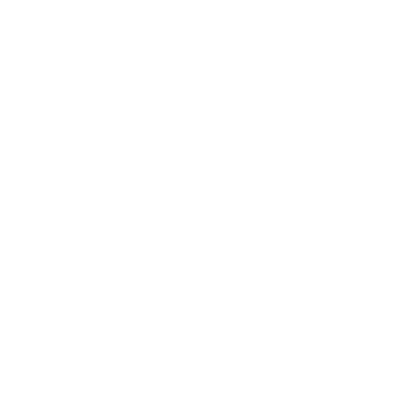لماذا ينكرون المعاد؟
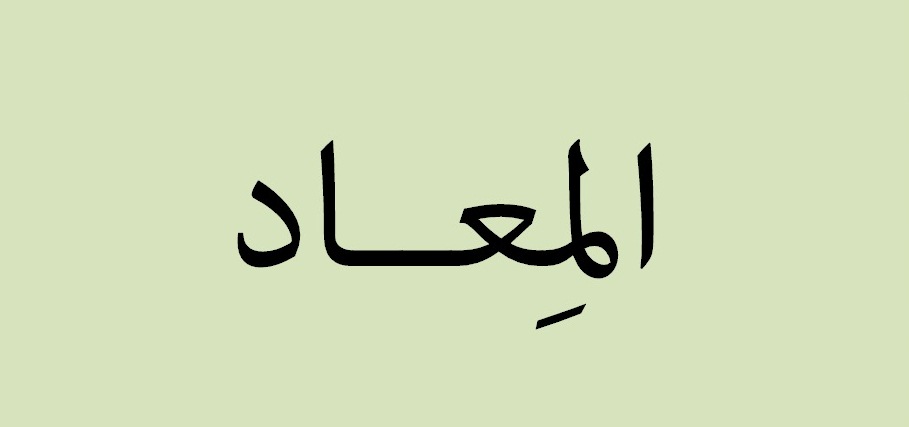
الباحثة: رجاء محمد بيطار
إن فطرة الله التي فطر الإنسان عليها، تدفعه إلى الإيمان بالله، وبالنبوة والإمامة، وتسوقه مدعّمةً بالمنطق السليم، والحكمة وحسن الاختيار، إلى الإيمان بالنبي المصطفى محمد، وبالأئمة الأطهار من بعده، عليهم جميعًا صلوات الله وسلامه، وقد تقدّم البحث في هذه الناحية، وكان لنا مع منكري هذه الحقائق الثابتة والعقائد الحقّة، وقفاتٌ وتعليقات، وردودٌ على الشبهات، بحسب ما وفقنا الله له من البيّنات...
على أن الإيمان بالمعاد، يحتلّ واجهة إيمان البشر بالعقائد والأديان، إذ قلما نجد دينًا اتّبعه البشر منذ بدء الخليقة، لا يكرّس الحياة بعد الموت كحقيقةٍ واقعة، فحتى الفراعنة القدماء، بلغ إيمانهم بهذه العقيدة حدًّا دفعهم إلى بناء الأهرامات لتكون منازل لآلهتهم، ملوكهم، في الحياة الأخرى... كما آمن الإغريق القدماء بالعالم السفليّ الذي تذهب إليه أرواح الموتى بعد الموت، بينما آمن الرومان بأن الإنسان عندما يموت يسافر تحت الأرض ويعبر نهر الموت...، أما المجوس فقد آمنوا بالعالم الآخر، حيث تتمّ محاسبة البشر بعد موتهم، بينما آمن البوذيون والهندوس بأن الموت تليه حياةٌ أخرى، ولكن هذه الحياة هي للروح، بجسدٍ ومكانٍ وزمانٍ جديدين، أي أن الأرواح باعتقادهم تتناسخ...
لسنا بصدد استعراض ديانات الأولين والآخرين، ولكننا أردنا أن نبيّن أن الديانات السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام، بالرغم مما لحق اليهودية والمسيحية من تحريف، وما لحق بعض فئات المسلمين من تضليل، تؤمن بالمعاد، أي بعودة الإنسان بعد الموت لتلقّي الحساب من الله تعالى عما فعل في عالم الدنيا، وأن الديانات الوضعية الأخرى أيضًا لها رؤيتها في هذا الجانب، مما يدفعنا إلى ربط عقيدة المعاد بالجانب الفطريّ للإنسان، إذ أن الحضارات بأجمعها، متطوّرةً كانت أو بدائية، تكرّس هذه العقيدة، وتعتبرها من المسلّمات... ذلك أن الفطرة السليمة ترفض أن يكون الموت نهاية، وأن تبقى الذنوب والخطايا بغير حساب، والحسنات والصالحات بغير ثواب.
على أن المنكرين للعقائد الإلهية أنكروا هذه الحقيقة، وليس ذلك بمستغرب، فمن لا يؤمن بالله وملائكته وأنبيائه ورسله، لن يؤمن حتمًا بمعادٍ وحساب، ولذا فإن إنكار المعاد مرتبطٌ بإنكار هذه العقائد.
بل لعلّ إنكار المعاد هو جذرٌ من جذور إنكار الألوهية، إذ لا يمكن أن يدّعي مدّعٍ أن المنطق السليم يدعو لإنكار الله جلّ وعلا، ففكرة الوجود الإلهي هي من أجلى الأفكار وأوضحها وأصفاها، وأكثرها انسجامًا مع المنطق السليم، فهو مسبب الأسباب وهو أول كلّ شيءٍ وآخره، وكما قال سيد الشهداء إمامنا الحسين عليه السلام في دعاء عرفة: "كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، حتى يكون هو المظهر لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك"...
أما أن يكون إنكار المعاد أحد دواعي إنكار الألوهية، فذاك محتوم، إذ أن هذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم، هو في قرارة نفسه يعلم أن له صانعًا، فهو يدعوه مرةً باسم الطبيعة، ومرةً أخرى يسميه طاقةً لا نهائية، وحين يتجرّد من رفضه للإرادة العليا، يسمّيه بالخالق، وإن هذا الإنسان لا يدفعه لإنكار الألوهية، ولا يردّه إلى أسفل السافلين إلا إنكاره لأنعم الخالق عليه، وأول سبل هذا الإنكار أن لا يقرّ برقابته على أفعاله، وبمحاسبته له على أعماله، فهو يريد أن يمضي في هذه الحياة، بلا رقيبٍ ولا حسيب، وأن لا يكون مؤاخذًا بقولٍ أو عمل، وهو يرضى بالانصياع للقوانين الوضعية لأنه يستطيع تغييرها متى شاء، أما القانون الإلهي الذي لا يد له في تغييره وتحويره، فهو يرفض الامتثال لأمره... ومع أن عقله يقوده إلى الاعتراف بوجود الله، إلا أنه لا يريد إلهًا يأمره وينهاه، بل يريد إلهًا على مقاسه، يقوّله ما يشاء ويطوّعه لما يشاء؛ هذا هو لبّ الموضوع، إذ ماذا يضرّ الإنسان لو اعترف بالمعاد؟! إنه إصراره على الابتعاد عن الرقابة والمحاسبة، فهو قد اتّخذ إلهه هواه... ولا يرضى بسواه.
إن إنكار الإنسان للمعاد يعود لرفضه أن يتمّ تقييده بضوابط تحدّ حريّاته، وقد أثبت التاريخ الإنسانيّ منذ بداياته، أن الحرية المطلقة تدمّر البشرية، إذ أن العقل البشريّ إن لم يمضِ وفق ضوابط محدّدة، لا حدود لشروره كما لا حدود لإبداعه، والانضباط من خلال الضوابط هو للشرور دون الإبداع...
ولو طرحنا سؤالًا على الإنسان، أن هل أنت ملمٌّ بكلّ تفاصيل جسدك وعقلك وروحك؟!... إن الجواب المنطقيّ هو "كلا"، إلا لمن استكبر... والسؤال الثاني الذي لا بدّ منه: طالما أنك لستَ ملمًّا بكلّ خَلقك، فكيف تعلم ما هو الأصلح لك ولغيرك؟! سيكون الجواب هو الخبرة والتجربة، التي تظهر صلاح الأمور أو فسادها، ولكنها طبعًا ليست قاعدةً عامة، فالخبرة محكومة بظروفٍ تختلف بين إنسانٍ وإنسان... وهنا يأتي الردّ الواقعيّ الذي لا يمكن إنكاره: طالما أنك لا تعرف عن نفسك وهذا الكون إلا القليل، بلحاظ المعرفة الكلّية به، والتي لم ولن يحيط بها أحد، فلماذا لا تقرّ بأن صانع هذا الكون وصانعك هو الأدرى بما يصلح لك؟ّ وهو الذي يوجّهك ويرشدك، ويراقبك ويحاسبك، وهو قد ترك لك حرية الاختيار ما بين الخير والشر، ليتبيّن لك لا له صلاحك أو فسادك، وعلى أساس ذلك تتمّ محاسبتك... وطالما أن الحياة الدنيا هي زمانٌ محدودٌ بعمرٍ محدود، فهي مجال الاختبار، وفي الآخرة يتمّ الحساب... ولو استوى الذين يعلمون ويعملون مع الذين لا يعلمون ولا يعملون، ولو كان الجميع أخيارًا وأشرارًا ينالون نفس المصير، الذي هو الموت النهائي الأبدي، لما كان هناك عدلٌ وإنصاف، وحاشا لمن خلق الإنسان في أحسن تقويم، والكون بأحسن تصميم، أن لا يكون عادلًا منصفا، وإنما تتجلّى آيات إنصافه في كلّ ما خلق، بدءًا من الذرة اللامتناهية الصغر، إلى المدى اللامتناهي البعد والكون اللامتناهي الكبر...
إن الإنسان الذي لا يؤمن بالحساب الأخرويّ هو إنسانٌ قلِق، يعيش اللحظة للّحظة، ولا يدري ماذا يأتي بعدها، وإذا ظُلم علم أنه لن ينال حقّه إلا في الدنيا، فإذا لم ينله كان محبَطا، وإذا ظَلم وقد علم أن لن يحاسبه أحدٌ غير السلطة الدنيوية، فلعل لديه من الوسائل ما يمكن أن يغطّي به ظلمه عنها، ويستمرّ فيه حتى نهاية عمره، وبهذا يكون قد أخلّ بالنظام الكونيّ له ولسواه، وهذا النظام قائم على التوازن والاعتدال، ولو اختلّ لما كان هناك كونٌ ولا حياة.
إن فكرة المعاد هي فكرةٌ حتميّةٌ لا يستقيم أمر العدل الإلهيّ والاعتدال الكونيّ بدونها، وهي ضرورةٌ ليستقيم أمر الإنسان في الحياة الدنيا، فإذا كانت بعض الأنظمة الوضعية قد استمدّت من روح الشرائع ما استقام به وضع بعض البشر في بقاعٍ محدّدة، فهي قد وصلت إلى حلولٍ جزئية، ولم تلامس جوهر المشكلة، ألا وهو الإنسان ككلّ، روحًا وجسدا، ولهذا بقيت مشاكل الإنسان الروحية رهن اعتقاده؛ إن الحلّ الوحيد إذًا هو في العودة إلى الشرائع الإلهية، والإسلام تحديدًا، فهو ختام الشرائع وأكملها وأبعدها عن النقص والتحريف، وهو دستور الحياة الدنيوية والأخروية للإنسان، والاعتقاد بالمعاد هو من أصوله، لأنه المصداق الحقّ لقيمة الإنسان الفعلية، فالخالق جلّ وعلا أجلّ شأنًا وأرفع قدرًا من أن يخلق عبثا، وقد كرّم الإنسان بعدله اللامتناهي، ووضع له محكمة العدل الإلهي، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، إلا من أتى الله بقلبٍ سليم، فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرًّا يره.