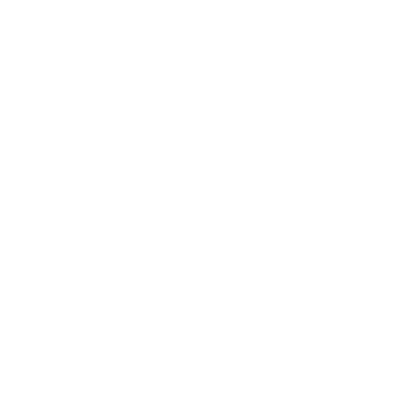المقالة الثالثة: "لماذا ينكرون محمّدًا (صلى الله عليه وآله وسلم)؟" (1)

الباحثة: رجاء محمد بيطار
الصورة: قاسم العميدي
{يا أيها النبيّ إنّا أرسلناك شاهدًا ومبشّرًا ونذيرا}[1]... صدق الله العلي العظيم.
بعدما انطلقنا في المقالة السابقة لنناقش ونجيب على سؤال "لماذا ينكرون النبوة؟"، نتابع في هذه المقالة لنجيب أيضًا على سؤال "لماذا ينكرون محمّدًا؟"، وذلك في تسلسلٍ منطقيٍّ يتناسب مع تسلسل الفكرتين وتتابعهما، فمنكرو النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم كما أسلفنا إما منكرون لفكرة النبوة بحدّ ذاتها، وهو ما ناقشناه في المقالة السابقة، وإما منكرون لنبوّته هو (صلوات الله وسلامه عليه)، ولذا فإن هذه المقالة تتمحور حول هذا الموضوع بالذات، أي مناقشة أسباب إنكار نبوة النبيّ الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلّم) لمن يُنكرها، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: إن المرحلة الأولى من مراحل الردّ على المنكرين، هي إثبات جدارة النبي محمدٍ (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنبوة عقلًا ونقلًا، فقد أوضحنا في المقالة السابقة كيف أنه من الطبيعيّ عندما يريد الله أن يختار للبشر دعاةً وهداة، أن يكونوا أصدق وأتقى وأورع وأصلح أهل زمانهم، ولا يختلف اثنان في تاريخ محمد الصادق الأمين، الذي نشأ وترعرع في بيئةٍ تعبد الأوثان، فلم يعبد إلا الله الواحد القهّار، وتقترف المحرّمات، فلم يتدنّس بمحرّمٍ قطّ، وتئد البنات وتصنع الموبقات، فكان أكثر نقاءً وطهرًا وإنسانيّةً من كلّ بني عصره، بل من كلّ إنسانٍ في العصور السابقة واللاحقة، كلّ هذا قبل أن يُبعث بالنبوة، بشهادة أعدائه قبل أوليائه، ثم استمرّ كذلك طبعًا بعد البعثة، وقد عُرف عن العرب أنهم رغم ما كانوا غارقين فيه من رذائل، إلا أنهم يقدّرون الفضائل وأصحابها، فحتى مناوئوه ومخالفوه والكافرون بنبوّته كانوا يعلمون أنه أفضل الناس، إلا أنهم رفضوا الاعتراف به نبيًّا لأن ما أتى به كان مخالفًا لمصالحهم وأهوائهم، وليس أبيَن من ثقتهم به وبأمانته وصدقه وطيب خلقه، من إطلاقهم لقب "الصادق الأمين" عليه، حتى غدا لا يُعرف إلا به، وكانوا لا يستودعون أماناتهم وودائعهم إلا عنده، كما أنه عُرف بينهم بالحكمة أيضا.
ولعل خير شاهدٍ على أفضليّة النبيّ عند العرب قبل الإسلام وحكمته المشهودة لديهم، حادثة الحجر الأسود، ووضعه في موضعه بعد تجديد بناء الكعبة، حين حصل الخلاف بين القبائل على وضعه، فلم يصلوا إلى حلٍّ إلا برأيه السديد، إذ أشار عليهم بأن يضعوه في ثوب، وتمسك كلّ قبيلةٍ بطرفٍ من أطراف الثوب، حتى إذا حملوه قام الصادق الأمين بوضعه بنفسه في مكانه[2]، وكان كلّ ذلك مقبولًا لديهم، بل محبوبًا ومشكورًا، حتى إذا جاء بالنبوة رفضه أغنياء القوم ووجهاؤهم، لأن ما جاء به كان ينزلهم عن عروش استكبارهم، ويساوي بينهم وبين عبيدهم، ويمنعهم عما كانوا سادرين فيه من جهلٍ ولهو وفساد.
إن وجهاء مكة وقريش حاولوا أن يغروه بالملك ليثنوه عن الدعوة إلى الإسلام، في القصة المعروفة، فأرسل إليهم جوابه مع عمه وكفيله أبي طالب (رض) بقوله: "يا عمّ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك"[3]...
ولعلّ في حديث جعفر بن أبي طالبٍ (رض) مع النجاشيّ، ما يلقي الضوء على حال العرب قبل وبعد دعوة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم، ويلخّص مقتضى تلك الدعوة، إذ قال: "أيها الملك، كنا قومًا أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولًا منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحّده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، والكفّ عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور، وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدّقناه وآمنّا به واتّبعناه على ما جاء به من الله..."[4]
إن هذا الخبر وحده، الذي نقله العامة والخاصة، كفيلٌ بتوضيح الأمر بحيث لا يقبل الشكّ أو الارتياب، فاعتراض القوم وإنكارهم لنبوة النبي في الجاهلية لم يكن سببه خلاف عقائدي أو فكري، بل كان كإنكار كل الأقوام لأنبيائهم، وتلك قصة نوحٍ وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء شاهدةٌ على الاضطهاد الذي لاقوه في سبيل دعوتهم، وأول ذلك الاضطهاد تلك الجدليات الفارغة التي كانوا يعارضونهم بها، كمثل قول قريشٍ للنبيّ: {لولا نُزّل هذا القرآن على رجلٍ من القريتين عظيم}[5]، والقريتان هما مكة والطائف، وليس يعنينا تحديد الشخص المقصود بالعظيم، بل فهم المراد من الكلمة، فهم اشترطوا على الله (جلّ وعلا) أن يكون النبيّ أحد وجهائهم، واستخفّوا بمحمدٍ (صلى الله عليه وآله) ورفضوا نبوّته، لأنه كان فقيرًا لا يملك من حطام الدنيا شيئًا، كما أنه أتاهم بما لا قبل لهم بتغييره أو التفاوض حوله، فالنبوة ليست نفوذًا دنيويًّا وأمرًا طارئًا يتدخّل فيه البشر وفق آرائهم وأهوائهم، بل هو أمرٌ إلهيٌّ عليهم التسليم به حتى ولو لم يوافق رغباتهم، وكان ذاك هو جوهر الخلاف بين قريشٍ والنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.
كل هذه القرائن وغيرها يمكن أن تبلغنا بأفضليّة النبي (صلى الله عليه وآله) على سائر قومه وأقوام العرب، مما يجعله جديرًا بالنبوّة، كإنسانٍ مكتمل الفضائل، منزّهٍ عن النقص والعيب، صادق القول لا يكذب ولا يزوّر، وتلك هي صفات الأنبياء...
وكذا خاطب الله عزّ وجلّ المؤمنين بقوله جلّ من قائل: {قل يا أيّها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبيّ الأمّيّ الذي يؤمن بالله وكلماته واتّبعوه لعلكم تهتدون}[6].
إن نظرةً عامةً موضوعية إلى شخصية النبي بعظمتها وتفوّقها الإنسانيّ، تؤكّد أنه الأرقى والأجدر بمنصب النبوة، كما أسلفنا، أما الحجج الأخرى التي تدحض ادعاء المنكرين لنبوّته، فلا بدّ من إيراد الشبهات التي يطرحها هؤلاء، من أتباع الملل الأخرى، ومناقشتها وتفنيدها، واحدةً تلو الأخرى، وهذا ما سنقوم بمعالجته في المقالة التالية بإذن الله، وقد قال عزّ من قائل: {... ومن يؤمن بالله يهدِ قلبه والله بكلّ شيءٍ عليم}.
*(لماذا ينكرون...؟) سلسلة مقالات عقائدية تجيب عن أسئلة الإنكار العقائدي التي يواجهها المجتمع الإنساني منذ بدأ الخلق.
[1] سورة الأحزاب، الآية 45
[2] السيرة النبوية لابن هشام، ج1، ص209، و"المنتظم في تاريخ الملوك والأمم"، ابن الجوزي، ج2، ص324 و325
[3] السيرة النبوية لابن هشام، ج1، ص276 عن شرح نهج البلاغة، ابن أبي حديد، ج14، ص54
[4] دلائل الإمامة، محمد بن جرير الطبري الشيعي، ص12
[5] سورة الزخرف، الآية 31
[6] سورة الأعراف الآية 158