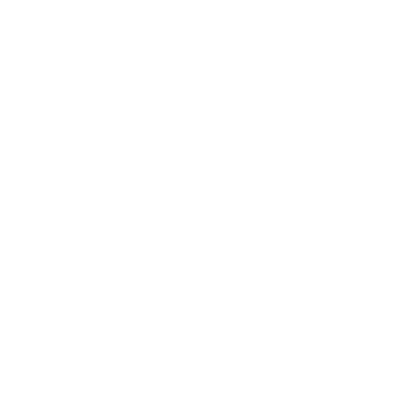مبدأ الحرية في النهضة الحسينية

من الأُمور الجليّة الواضحة في الثورة الحسينية أنّها ثورة تحرّر ضد قيود الظلم والاستعباد، فهي ثورة رافضة للظلم والتجبّر بأيّ شكل من أشكاله. وهذا الهدف وهو رفض الظلم والتجبّر يتّفق مع الفطرة الإنسانية، فإنّ الله خلق الناس أحراراً غير تابعين لجهة، ولا مكبّلين بقيود تذلّهم وتسلب كرامتهم، وهذا ما يشير إليه القول المعروف لعلّي بن أبي طالب(عليه السلام): «لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرّاً»([1]). فالحريّة هي الأساس الذي خلق الإنسان عليه، لكن ذلك لا يمنع من تشريع قوانين، وسنّ أنظمة تمكّن الأفراد والمجتمعات من التعايش فيما بينها؛ إذ بدون قوانين ستتحوّل المجتمعات إلى غابات يفترس فيها القوي الضعيف, فالحريّة المطلوبة إذاً هي تلك التي تتّفق مع القوانين المسنونة، ولا تتعارض معها، وهذه الحريّة كما كفلها الله سبحانه وتعالى لخلقه، وحيث إنّها أمرٌ فطري، فإنّ القوانين الوضعية أقرّتها أيضاً، ورفضت جميع أنواع الظلم الذي يتعرّض له الإنسان، سواء من الحكّام أم من غيرهم.
ومن أولويات الحريّة التي أعطتها القوانين الوضعية للإنسان هي حقّ الشعوب في تقرير مصيرها، وأنّ الشعب هو مصدر السلطات، وهو مصدر التشريع، وأنّه لا يمكن للحاكم أو غيره أنْ يفرض على الشعب أيَّ شكل من أشكال الدولة، ولا أنْ يطبّق عليه القوانين بالقهر والإجبار، بل أعطى للشعب الحريّة في أنْ يختار نوع الحكم الذي يشاء، وأنْ يختار دستوره بنفسه وفق آليات قد تختلف من بلد إلى بلد، فقد يكون عن طريق الاقتراع المباشر لأنظمة دستورية معيّنة، أو الاقتراع لاختيار برلمان يوعز إليه كتابة دستور معيّن، وهكذا، والغرض أنّ اختيار نظام الحكم وشكل الدولة ودستورها إنّما هو بيد الشعب.
وهذا الأمر تقرّ به حتى الدول الجائرة الاستبدادية؛ إذ لا تجد دولة تدّعي أنّها استبدادية، بل تعلن من حيث النظرية والقانون أنّها حكومة ناشئة من الشعب, ثمّ إنّ القوانين الوضعية ركّزت على احترام حريّة الفرد والمواطن، وحافظت على حقوقه في فقرات عدّة، فرفضت التمييز العنصـري، ورفضت الاضطهاد بشكل عام، وكذلك الاضطهاد الناشئ من اختلاف فكري، أو عقدي، أو ثقافي، بل أعطت للمواطن حريّة اختيار عقيدته وديانته من دون أيّ إجبار في ذلك.
الحرية في قانون حقوق الانسان
ونحن هنا نقتصر على ذكر بعض من فقرات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
المادة (1): «يُولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وُهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء».
المادة (2): «لكلّ إنسان حقّ التمتّع بكافّة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أيّ تمييز، كالتمييز بسبب العنصـر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو أيّ رأيٍ آخر، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو الميلاد، أو أيّ وضع آخر، دون أيّة تفرقة بين الرجال والنساء.
وفضلاً عمّا تقدّم فلن يكون هناك أيّ تمييز أساسه الوضع السياسي، أو القانوني، أو الدولي لبلد، أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد، سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاًّ، أو تحت الوصاية، أو غير متمتّع بالحكم الذاتي، أو كانت سيادته خاضعة لأيّ قيدٍ من القيود».
المادة (3): «لكلّ فرد الحقّ في الحياة والحريّة وسلامة شخصه».
المادة (5): «لا يُعرَّض أيّ إنسان للتعذيب، ولا للعقوبات، أو المعاملات القاسية، أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة».
المادة (18): «لكلّ شخص الحقّ في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحقّ حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة، وإقامة الشعائر ومراعاتها، سواء أكان ذلك سرّاً أم مع الجماعة».
المادة (19): «لكلّ شخص الحقّ في حريّة الرأيّ والتعبير، ويشمل هذا الحقّ حرية اعتناق الآراء دون أيّ تدخّل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقّيها وإذاعتها بأيّة وسيلة كانت، دون تقيّد بالحدود الجغرافية».
المادة (21): «(1) لكلّ فرد الحقّ في الاشتراك في إدارة الشؤون العامّة لبلاده، إمّا مباشرة، وإمّا بواسطة ممثّلين يُختارون اختياراً حرّاً.
(2) لكلّ شخص نفس الحقّ الذي لغيره في تقلّد الوظائف العامّة في البلاد.
(3) إنّ إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبّر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية، تجري على أساس الاقتراع السرّي، وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أيّ إجراء مماثل يضمن حرية التصويت».
وكذلك فإنّ هذه القوانين لم يفُتْها أنْ تشير إلى ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية، وإنصاف المظلوم من الظالم وغيرها ممّا يُقنِّن حرية الإنسان، وحفظ كرامته على كافّة الأصعدة.
وحينما أشرنا إلى أنّ الشعب هو مصدر التشريع، وقلنا إنّ الحريّة حقّ طبيعي لكلّ فرد ومجتمع، لا نعني أنّ الدول التي تقوم على نظام الانتخابات هي دولة عادلة، حقّقت لمواطنيها العيش الكريم، ودافعت عن حرياتهم، وضمنت لهم كافّة أنواع الحقوق، بل أردنا أنْ نشير إلى أنّ القوانين من الجهة النظرية تتبنّى مبدأ حرية الفرد والمجتمع، وتدعو إلى تطبيق العدالة الاجتماعية، ونبذ التفرقة والظلم، وإنصاف المظلوم من ظالمه.
والواقع أنّ هذه القوانين ـ بما تحويه من مفاهيم وقيم أخلاقية ـ لم تكن موضعاً للتطبيق في كثير من الدول، سواء تلك السابقة لوضع هذه القوانين أم اللاحقة لها؛ وسواء كانت تلك الدولة تؤمن بالنظم الديموقراطية أو غيرها من الدول الاستبدادية؛ لذا فالإنسان يعيش في دولة تُقرُّ قوانينُها الحريّات، لكنّه يعيش مُستعبداً ذليلاً، منهوب الثروات، فاقداً للكرامة، فكم من دولةٍ تُقصـي أبناءها لمجرّد انتماءٍ مذهبي، أو حركةٍ فكرية، أو لكونه ذا لونٍ معيّن.
بل أحياناً يتعدّى الموضوع عدم تطبيق القوانين إلى وضع الدولة لقوانين جائرة تقوم بفرضها على الناس، بل لربّما يكون القانون في فترة قانوناً عادلاً، ينسجم مع مصالح المجتمع وتطلعاته، وفي فترةٍ أُخرى يكون قانوناً ظالماً، ونتيجةً لذلك يقع التنازع بين قوّة الدولة التي سنّت قوانين ظالمة، أو لم تطبّق القوانين المسنونة، وحكمت الشعب بالتجبّر والغَلَبة، وسلب الحريّات، وبين قوة العقل البشري، والفطرة الإنسانية الداعيين إلى تطبيق العدالة، وبين هاتين القوَّتين تتوزع آراءُ الفلاسفة والكُتّاب والفقهاء وتتراوح، فمنهم مَن يغلِّب قوة العدل على قوّة السلطان، فيُبيح تحدّي قوى الدولة فيما تفرضه من قوانين ظالمة، ويتدرّج ذلك من مجرَّد العصيان إلى الثورة، وهذا ما أخذت به الثورة الفرنسية فيما أعلنتْه من حقوق الإنسان؛ إذ اعتبر أحد الدساتير التي تمخّضت عنها أنّ الثورة على الظلم ومقاومته هو من ضمن هذه الحقوق([2]).
الثورة من اجل الحرية
فالثورة إذن تعدُّ أحد حقوق الإنسان، فيما إذا تعرّض إلى الظلم والاضطهاد، وصُودرت حريّاته؛ لأنّ شرعية الحكومة تسقط حين تتخلّى عن تطبيق القوانين بصورة صحيحة، ولأنّ هناك علاقة بين الحاكم والمحكوم، مكّنت الحاكم من ممارسة صلاحيته وفق شروط معيّنة، أما إذا تنكَّر الأُمراء للشعوب، وطرأ ما يُبطِل العقد أو يخلُّ بشروطه، فإنّه يتمخّض عن ذلك واجبُ الثورة على الأمير؛ لأنّ الشعب لم يفوِّضه السيادة تفويضًا مطلقًا، بل تفويض كان مقروناً بشرطٍ فاسخ... فمنذ القرن السادس عشر شرح جون لوك نظريته عمَّا أسماه: (مبدأ الحقِّ الخفي للثورات)، حيث سلَّم بالحق في الثورة ضدّ السلطة التنفيذية، وضدّ السلطة التشـريعية بسبب مساوئ الحكم والتشـريع، وقد دافع عن حقِّ الشعب في العصيان.
وقد استقرّ الاعتراف بحقِّ المقاومة في فقه القانون العام، فيقول العميد هوريو: إنّ حقَّ المقاومة ليس إلّا استدعاءً لحقٍّ قديم في الحرية، يعود ليؤكّد حقَّ المواطنين في الدفاع الشرعي ضد سوء استخدام السلطة.
ويقول العميد جني: إنّ حقَّ المقاومة هو الضمان الأعلى للعدالة وسيادة القانون.
ويقول لوفور: إنّ المقاومة هي ممارسة لحقِّ مراقبة السلطة المُعترَف به من المحكومين. ويذهب الفقيه الألماني إهرنغ إلى حدِّ جعل المقاومة هي النظرية الأصلية للقانون كلِّه، فيقول: إنّ القانون ليس هو المبدأ الأسمى الذي يحكم العالم؛ إنّه ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غاية.
إنّ الحياة فوق القانون، وعندما يصبح المجتمع في موقف الخيار بين احترام القانون والحفاظ على الوجود، فلا محلَّ للتردد، وعلى القوة أنّ تضحِّي بالقانون لتنقذ الأُمّة.
ويذهب العميد دوغيه في كتابه: (أُصول القانون الدستوري) إلى أنّ حقّ الثورة ما هو إلّا نتيجة منطقية لخضوع الحكّام للقانون.
وإنّ كلَّ إجراء يتَّخذه الحكّام مخالفٍ للقانون يخوِّل المحكومين سلطة قَلْبِ الحكومة بالإكراه؛ وهم إذ يحاولون ذلك، يهدفون إلى إعادة سيادة القانون...»([3]).
فالثورة إذاً على الظلم والتجبّر والاستبداد هي حقٌّ مشـروع للشعوب، كفلته القوانين الدولية، وصرّح به فقهاء القانون، وأوضحوا أنّ حقّ الثورة يستند إلى حقّ الدفاع المشروع، الذيّ يعدّ أهمّ موانع العقاب، يقول الدكتور عبد الله السلمو([4]): «أمّا إذا دخلنا إلى عالم الفقه والتشريع الدولي، لنرى المستند القانوني الذي يرتكز عليه حقّ الثورة: فيرى فقهاء الحقوق الجزائية أنّ حقّ الثورة يستند إلى حقّ الدفاع المشـروع، الذي أجمعت التشريعات الجزائية على أنّه أحد أهمّ موانع العقاب، سواء كان في المجال الفردي، أوفي المجال الجماعي، أي: الثورة لدرء العدوان على الوطن والمجتمع، وإلى هذا ذهب الفقيه الفرنسي (سوميير) بقوله: إنّ حقّ المقاومة يعتمد على حقّ الدفاع المشروع. (مبادئ القانون الأساسية: ص125).
كما أكد الفيلسوف البريطاني لوك، صاحب نظرية حقّ الثورة ما يلي: إنّ الشعب في حالة خيانة حكّامه ـ للأمانة التي عهد بها إليهم، سواء كانوا مشـرّعين أو منفّذين ـ يملك حقّ الثورة عليهم... إنّني أحبّ السلم، ولكن لا أُريد سلماً بأيّ ثمن، سلماً يفرضه الأقوياء على الضعفاء، يفرضه الغاصبون على الشعوب، سلماً يكون كالسلم المزعوم بين الذئاب والخراف. (لوك، محاولة في الحكومة المدنية: ص135).
وحقّ الثورة هو مجرّد حقّ تقرير المصير، ويُعتبر هذا المبدأ من المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وذلك تماشياً مع ميثاق الأُمم المتحدة، واضعاً البداية الأُولى والمهمّة في نشأة القانون الدولي المعاصر، والنظام العالمي بشكلٍ عام»([5]).
فالثورة ضدّ الظلم والطغيان وانتهاك حقوق الإنسان تكتسب الشـرعية القانونية، بل إنّ الثوار يُعتبَرون موضع تقدير واحترام؛ لما قاموا به في سبيل فكّ قيود العبودية التي فرضتها السلطات الجائرة، ومَن يُقتل في ذاك الطريق تخلّده الشعوب، ويبقى رمزاً تتفاخر به الأُمّة، وتجعل من شخصه ـ خصوصاً إذا كان قيادياً معروفاً ـ قدوة وأنموذج تحتذي به، وتحثّ الناس على السير إثر خطاه، وتثير وتهيّج الرأي العام في الاستقاء من طريقته، وتشحذ الهمم عن طريق التغنّي بذكره.
ومن أوضح مصاديق مشروعية الثورات ضدّ الظلم والتجبّر هو ما اكتسبته الثورات ـ التي انطلقت في شتى أصقاع العالم، رافضةً للذلّ والخنوع ـ من تفاعل إنساني منقطع النظير، ومن اعتراف جماهيري ورسمي بها.
غير أنّه من الطبيعي أنّ التغيير إذا أمكن أنْ يكون بالطرق السلمية، ومن دون قتلٍ وقتال، فإنّ القوانين حينئذٍ ترفض الثورة، وتدعو الشعوب إلى التظاهر السلمي، ما دام يكفل تحرر الإنسان من ذلّ الاستعباد، ويحقّق له أهدافه من الحريّة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإسقاط عرش الطاغوت.
نهضة عاشوراء والحرية
ونحن إذا ما رجعنا إلى الظروف التي اكتنفت ثورة الإمام الحسين (عليه السلام)، لوجدناها جامعة للشرائط القانونية، فضلاً عن الشرائط الشرعية التي ذكرنا أكثرها فيما مضى.
فالخليفة في زمن الحسين (عليه السلام) لم يُنتخب بصورة دستورية صحيحة، بل ساهمت السلطة الحاكمة آنذاك بكلّ ما أُوتيت من قوة، واستخدمت الترهيب والترغيب، وإغراء الناس بالأموال في سبيل تحصيل البيعة له، ومع ذلك لم تحصل له البيعة من الجميع، بل عارضها جملة من أهل الحلّ والعقد، وعلى رأسهم الإمام الحسين (عليه السلام).
ثمّ إنّ الخليفة كان يهدف إلى إقصاء دستور المسلمين، وتبديله بأحكام ظالمة جائرة، فكان الحقّ لا يُعمل به، والباطل لا يُتناهى عنه، بل إنّ الخليفة بنفسه كان متجاهراً بمخالفة الدستور، تاركاً للصلاة، شارباً للخمر، مستخفّاً بكلّ القيم والمبادئ.
أضف إلى ذلك أنّ الحريّات مُصادَرة، وأنّ القتل والترهيب مصير كلّ مخالف.
فالحكومة الأُموية بقيادة معاوية قمعت كلّ أنواع الحريّات، وقتلت عدّة من الصحابة والصالحين؛ لمجرد ولائهم لعلي بن أبي طالب(عليه السلام)، وهو ما يُعبّر عنه اليوم بالقتل على الهويّة، ثمّ سلّطت فاجراً فاسقاً على رؤوس المسلمين، لا يملك ذرة من كياسة الحكم، ليسير على نفس أُسلوب القمع والإقصاء لكلّ مَن يخالفه بالرأي، فكان أوّل كتابٍ له، والهادف لتوطيد حكمه وسلطانه هو أخذ البيعة من الحسين(عليه السلام) وغيره ممَّن لم يبايعوا بكلّ طريقة، ولو استلزم ذلك القتل.
ولم يكن الحسين (عليه السلام) ليبدأ حركته بقتالٍ، بل ابتدأ ذلك بأُسلوب الرفض لبيعة هكذا حاكم، مبيّناً أنّ كلّ حرّ أبيّ لا يمكن أنْ يبايع مثل هذا المنحرف «ومثلي لا يبايع مثله»([6]).
وعدم البيعة هو حقٌّ طبيعي للإمام الحسين (عليه السلام) كفلته الشـريعة والقوانين المداعية بحقوق وحريّة الإنسان، خصوصاً أنّ الخليفة لم يحصل على شرعية البيعة وفق أُطرها القانونية الصحيحة، لكنّ يزيد وأذنابه خشوا إنْ لم يبايع الحسين (عليه السلام) سوف تُفتضح عدم شرعية حكمهم، فحاولوا أخذ البيعة بكلّ صورة ولو القتل، ولمّا أحسّ الحسين(عليه السلام) بذلك ترك المدينة وغادر إلى مكّة، وكلّ همّه رفض إعطاء الشـرعية لهؤلاء الظلمة، مصـرّحاً بأنّ هدفه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفي مكّة أيضاً كانت هناك محاولة لاغتياله (عليه السلام)، ممّا أدّى به أنْ يتحرّك صوب العراق، مصرّاً على هدفه في نصرة الحقّ وكشف الباطل وتعريته.
والغرض أنّ الحسين (عليه السلام) رغم ما يملكه من غطاء شرعي وقانوني لثورته، من قمعٍ للحريّات، وتكميمٍ للأفواه، وسلبٍ للإرادة، واغتصابٍ للخلافة، ودرسٍ للشريعة، إلّا أنّه ابتدأ ثورته برفض المبايعة، وبدأ يبيّن أهدافه من الثورة، وأنّها لإحقاق الحقّ وإبطال الباطل وإنصاف المظلوم، ولمّا رأى أنّ القوم لا تنفع معهم الكلمة، ولا يحرّك ضميرهم خطاب الحقّ، وأنّهم يسعون في قتله بشتّى الوسائل، استمر بصرخته المدوّية الرافضة لكلّ أنواع الظلم والتجبّر، حتّى سالت دماؤه الطاهرة في أرض كربلاء، ليوقض معها ضمير الأُمّة، وليبعث فيها روح التضحية والفداء من أجل القيم والمبادئ.
فالثورة الحسينية كونها ثورة نابعة من الضمير الحي، ومنطلقة من الفطرة الإنسانية، منادية بتحرير الإنسان والحفاظ على كرامته؛ استطاعت أنْ تفرض مشروعيتها وفق قوانين تأخّرت عنها مئات السنين.
فحين نحاول أنْ نؤطّر الثورة الحسينية بالأُطر القانونية؛ إنّما لنكتشف أنّها ثورة تتماشى مع كلّ أنواع التقنين، وأنّها ثورة تنبع من الفطرة السليمة، وأنّها محلّ اتفاق بين آراء العقلاء على مختلف توجّهاتهم وانتماءاتهم..
مقتبس من كتاب (الأُطر الشرعية والقانونية لثورة الإمام الحسين)
تأليف: الدكتور حكمت الرحمة
مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينة
الصورة: قاسم العميدي
([1]) محمّد عبده، شرح نهج البلاغة: ج3، ص51.
([2]) اُنظر: عبد الهادي عباس، مقال تحت عنوان: (حقّ الإنسان في مقاومة القوانين الجائرة)، مجلّة معابر، منشور على شبكة الأنترنت:
http: //www.maaber.org/issue_january05/non_violence1.htm
([3]) المصدر السابق.
([4]) رئيس المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأُستاذ في القانون الدولي في الأكاديمية العربية في الدنمارك، ومستشار قانوني.
([5]) السلمو، عبد الله، مقال تحت عنوان: (دراسة قانونية الثورات العربية والقانون الدولي)، منشور على الأنترنت:
https: //www.zamanalwsl.net/news/22805.html
([6]) ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص17.