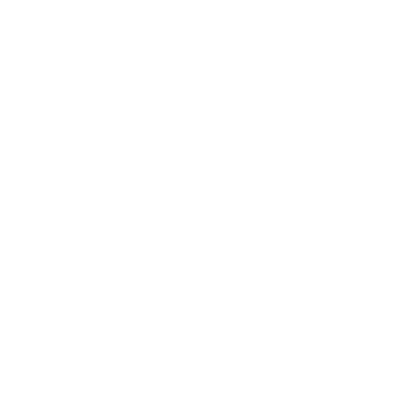ثورةُ الامام الحسين (عليه السلام) وشرعيةُ السلطة

حميد الطرفي
تُعد قضية الدولة واحدة من الضروريات الحتمية للمجتمع الإنساني وعلى مر العصور وتُعد السلطة واحدا من الأركان الأساسية لأية دولة فلا دولة من غير سلطة وتعني الأخيرة القدرة على إنفاذ الأوامر أو هي القوة في تشريع القوانين وإنفاذها وفرض الجزاءات على مخالفتها وشكلت قضية من يتصدى لهذه السلطة في المجتمع السياسي الإسلامي مادة أساسية في اختلاف المسلمين بعد وفاة رسول الله ( ص) ، وذلك ناتج من الطبيعة الخاصة للدين الإسلامي التي تميز بها عن غيره من الأديان فهو شريعة ونظام ، وعقيدة وعمل ، أو هو دين ودولة ولم يشذ عن هذا الوصف إلا نفر قليل من المفكرين المسلمين .
وإذا كانت السلطة بهذا المقدار من الأهمية فإن شرعيتها أهم من ذلك ويعرف فقهاء الدستور الشرعية بأنها " مفهوم سياسي مركزي يرمز إلى العلاقة القائمة بين الحاكم والمحكوم المتضمنة توافق العمل أو النهج السياسي للحكم مع المصالح والقيم الاجتماعية للمواطنين بما يؤدي إلى القبول الطوعي من قبل الشعب بقوانين وتشريعات السلطة السياسية ".
ومن خلال التدقيق بالتعريف أعلاه نكتشف ركيزتين أساسيتين للشرعية : الأولى منظومة القيم والعادات والأخلاق والقوانين التي يؤمن بها المجتمع ومدى مراعاة السلطة لها .
والثانية :هي القبول الطوعي للأمة أو الجماعة أو الشعب لأوامر هذه السلطة سواءً كانت على مستوى تشريعات القوانين أو تنفيذها
وبالتأمل في الواقع الإسلامي نجد أنه بعد وفاة الرسول ص وتجاوز النص الذي أوصى به النبي الأكرم بالإمرة والخلافة والإمامة لعلي عليه السلام حاول الإمام جاهدا تصحيح المسار وعمد أن تكون السلطة اقرب ما يمكن إلى الإسلام فهو يُشير ويُستشار ويتدخل في القضاء ويتواصل مع المحرومين ويراقب ويحاسب في بعض الأحيان.
وظل الإمام يحذر بعد توليه الخلافة من أيام قادمة تنحى فيها السلطة منحى خطيرا ، بعيدا عن مبدأي النص والشورى وسيشكل ذلك اخطر انقلاب على الشرعية وسيتعرض الإسلام إلى أزمة حكم حقيقية ما لم ينتبه المسلمون إلى خطورة ما يجري من تحريف لتعاليم الدين وشرعة سيد المرسلين فنراه يقول :" قاتلوا الخاطئين الضالّين، القاسطين المجرمين، الذين ليسوا بقرّاء للقرآن، ولا فقهاء في الدين، ولا علماء في التأويل، ولا لهذا الأمر بأهل سابقة في الإسلام. واللَّه، لو ولَوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل .) ( تاريخ الطبري ج3 ص117)
ولعل أهم ما تميز به الحكم القيصري والكسروي هو طريقة التوريث في الحكم فضلا عن الظلم والاضطهاد لشعوبهم الا ما ندر من ملوكهم . ويشير الإمام ع بطريقة أوضح إلى الاستئثار بالسلطة بقوله :" أما إنكم ستلقون بعدي ذلا شاملا، وسيفا قاطعا ، وأثرة يتخذها الظالمون فيكم سنة " (نهج البلاغة ، ج1 ، ص95)
وفي الفترة التي حكم بها معاوية ( 40-60هق) سعى جاهدا لان يسير بشرعية السلطة باتجاه تغيير المنظومة القيمية للمجتمع بما يجعلها تتوافق وتتلاءم بما يؤمن به هو لان ذلك هو السبيل الوحيد لمنع الرفض الشعبي وبالتالي تعرض شرعية سلطته للاهتزاز إن لم نقل لفقدانها فراح ينأى بالأمة بعيدا عن آل محمد وفضلهم وعلمهم وورعهم وتقواهم ثم عمد وبطرق مختلفة إلى تغييب النصوص التي أكدت على ولايتهم وإمامتهم واخذ يؤسس لان يكون هو الوارث الحقيقي للسلطة بمنظار ديني كونه خليفة الله ليحيط ذاته بالهالة المقدسة استغفالا لبسطاء الأمة وبمساعدة من تعاون معه ممن غرته الدنيا وباع حظه من الآخرة بحفنة من الدراهم فأراد أن يسبغ على تصرفاته المخالفة لروح الشريعة لباسا دينيا وكأنه ذائب في الشريعة ومؤمن بالعقيدة ، فهو يخاطب الناس مثلا وعنده وجوه الناس بقولة :" الأرض للهّ، وأنا خليفة الله، فما آخذ من مال الله فهو لي ، وما تركت منه كان جائزاً لي ". (المسعودي ، مروج الذهب ،ج3، ص52)
وما أمر معاوية بسب علي(عليه السلام) على المنابر واتخاذ ذلك سنة من بني أمية مدة ثمانين عاما إلا لتعزيز شرعية الحكم له ولبني أمية من بعده من خلال تشويه صورة صاحب الحق الشرعي فيه ، صورة صورة علي وأولاده في عيون أهل الشام ومنهم لبقية الأمصار حتى بات طلب إعادة الحكم لأهله واسترجاع الشرعية أمر يبعث على الاستغراب من أهل الشام إذ كيف يكون الحكم لمن يسب على المنابر خمس مرات باليوم ؟ وهذا ما يريده معاوية .
وإدراكا منه لأهمية شرعية السلطة عمد الإمام الحسن لتوقيع الصلح وهو يعلم أن معاوية لا يطبق جل ما وقعه معه أن لم نقل كله لكنه ألزم معاوية أن تعود إدارة أمور الأمة من بعده للإمام الحسن (ع) فان لم يكن فللإمام الحسين (ع) ومهما تنصل معاوية من بقية عهوده ومواثيقه فانه لا يستطيع التنصل من هذا العهد إلا أن تخرج سلطة من يخلفه عن شرعيتها .
لقد كان أمام الحسين (ع) خياران لا ثالث لهما إما تمرير خلافة يزيد وإعطائها الشرعية رغم تجاوزها الأصلين السابقين للشرعية وهما النص والشورى-التي تم ادعائها- وإضفاء أصل ثالث لشرعية السلطة وهو الوراثة وإما المواجهة لسلب شرعية الحكم ليس من يزيد فحسب بل من كل من يليه على هذه الشاكلة وأيا كان سواء من بني أمية أم من بني العباس ، فلا داعي لتكرير ثورة الحسين ما دام قد عرف للقاصي والداني سقوط شرعية الحكم عن الحكام .
فالإصلاح الذي طلبه الحسين عليه السلام في ثورته هو إصلاح نظام الحكم الذي فقد الشرعية ، وقوله مثلي لا يبايع مثله لان هذه البيعة تعني إضفاء شرعية على طريقة مبتدعة في الحكم وتقلد السلطة في المجتمع السياسي الإسلامي ويقينا أن الحسين (ع) لا يفعل ذلك .
لقد مورست بعد وفاة النبي (ص) أساليب مختلفة لِلَيّ أعناق الحقائق وتغيير وجهتها ولتبرير كل الألوان والأشكال التي تم بها غصب الحق من أهله وتجاوز الشرعية ، ورغم الاحتجاجات الكثيرة للامام علي (ع) واعتراضاته المتكررة تلميحا وتصريحا إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتسليط الضوء على شرعية الحكم ولم تستطع الامة التمييز بوضوح بين ما هو شرعي وغير شرعي واستطاعت تلك التبريرات أن تصنع التوافق بين السلطة والأمة وبهذا وفرت ركنا من أركان الشرعية التي اشرنا لها سابقا ، فكان لا بد من وسيلة فعالة وصدمة كبيرة ولافتة واضحة تبين للأمة أنها لم تكن على بصيرة كافية لتحديد السلطة الشرعية وسيلة لا تنفع معها التبريرات والتدليس والخداع وبالفعل فلم يجد يزيد وبنو أمية قاطبة لم يجدوا ما يبررون به فعلة يزيد وقتله الحسين وتقطعت معظم حبال الشرعية التي حاكها معاوية وجد في نسجها لعشرين عاما بل بشكل أدق طيلة ولايته الشام منذ أيام خلافة عمر بن الخطاب في 15للهجرة حتى وفاته في 60 للهجرة وبات معظم المسلمين يتربصون بسلطة بني أمية الدوائر حتى سقوط الدولة عام 132هق . ولو تأخر الحسين ع عن هذا الدور لطمس تماما حق أهل البيت وإمامتهم فيزيد هو أول خليفة يأتي بالتوريث في دولة المسلمين الفتية ، ورغم ما عرف عن معاوية من دهاء وغدر ومكر إلا أن ظروف انتقال الخلافة إليه تختلف تماما عن التوريث بل لابستها ظروف غاية في التعقيد انتهت بصلح الحسن(ع) ، وهو صلح لو لم يكن فيه إلا انتقال الخلافة بعده للحسن(ع) وان لم يكن فللحسين (ع )لكفى بذلك تحديدا وتوصيفا لشرعية السلطة وشرعية الثورة . ففي الوقت الذي فقدت فيه سلطة بني امية شرعيتها أو بتعبير أدق بانت فيه لا شرعيتها واستهتارها بالشريعة واستبدادها بالمر دون اهله اكتسبت فيه ثورة الحسين الشرعية الكاملة وراحت تفتح الافاق امام اعين الغافلين عن حق محمد وآل محمد ولا زالت حتى اليوم .