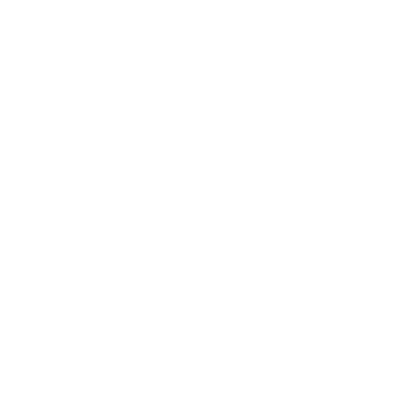الأصل الاسلامي للديمقراطية الحديثة
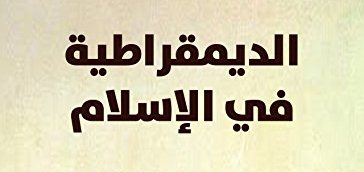
ناصر الخزاعي
تتعالى بين حين وآخر مجموعة من الأصوات النشاز التي تدّعي احتواء الاديان السماوية الثلاث على منظومة بنيوية تجعلها تعادي القيم الليبرالية والديمقراطية الحديثة وبأن الاديان السماوية، ولا سيما الدين الاسلامي لا يمكن ان تلعب اي دور ايجابي في تعزيز مبادئ الاختلاف وتكريس ثقافة الحوار وبالتالي فالأديان ليست قادرة على منع الصراعات الايديولوجية والطائفية والدينية التي تصر تلك الاصوات على أنها صراعات تهدد البلاد الاسلامية - خصوصاً - بسبب افتقار الوعي الجمعي لأهل تلك البلدان الى التأسيس الديمقراطي الصحيح أسوة بأوربا التي تحولت إلى مجتمعات تصنيع وتحديث مفاهيمي لكل القيم المتوارثة، وهو ما سنحاول ان ننفيه في هذه المقالة الموجزة لتأكيد مبدأ رسوخ فكرة الديمقراطية وحرية الاختيار في المنظومة البنيوية للاسلام كدين سماوي يؤيد فطرة الله في خلقه ومعرفته لصوالح أمور الناس ولمنافعهم العامة والخاصة.
ومن المعروف أن الشريعة الاسلامية قد قررت أن مسؤولية الإنسان تنبني وتؤسس على إرادته الحرة واختياره الهادف لما يقوم به ويفعله. أي أن أساس المسؤولية وما يتبعها ويترتب عليها من جزاء هو ما يفعله الإنسان بمحض تصرفه وإرادته وهذا ما بينه القرآن الكريم في كثير من آياته المتكررة المتوجهة إلى عقل الإنسان وإسناد كل ما يقوم به من أفعال إلى إرادته، وتأكيد مسؤوليته وحسابه على ما يفعله من خير أو شر مما يبرز أن للإنسان إرادة حرة وأن له كسباً واكتساباً وأنه يهدي نفسه بنفسه ويضل نفسه بنفسه، ولو عدنا إلى القرآن مرة ثانية فنجده يتعامل مع الاقليات الاخرى التي تعيش في كنف المسلمين في غاية التهذيب والاحترام مهما كانت ديانتها ومعتقداتها ما دامت هذه الاقليات مسالمة وتود العيش باحترام ضمن مجتمع متآلف متحاب...
أما في علاقة المسلمين في الديانات السماوية الأخرى فقد انطلق الاسلام من مبدأ متحضر تقره -الآن- كل الدساتير الانسانية وملخص هذا المبدأ ان كل اشكال الايمان المتعددة لا تقل منزلة عن نظيرتها في الاسلام، وهي في النهاية تجسيد لحضور الاله المتعالي في الحياة البشرية مادام الله (جل ثناؤه) قد فطر الناس على فطرة واحدة تقود إلى معرفة الله وعبادته لكونه خالقهم وإليه مصيرهم، أي أن الاسلام يقر أصلا بكونية معرفة الله وبكونية توجه الناس لعبادته وإقرارهم بهذه العبودية بغض النظر عن ديانتهم، حيث يقول القرآن: (كانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ)، وهو ما يؤكد احترام الاسلام للآخر المختلف، وما يؤسس بالوقت نفسه خطابا عاما لتعددية دينية متوافقة لخدمة الصالح العام والعيش المشترك السليم وهذا جوهر من جواهر الديمقراطية التي يتشدق المتشدقون بأنها لن تنتعش الا في ظل مجتمعات ليبرالية أوربية تعتمد التصنيع والسوق الحرة لنجاح أي تجربة ذات بعد ديمقراطي.
وعودة أخرى للقرآن كتاب المسلمين الاول تثبت لنا أهمية الخطاب الالهي المتكرر بضرورة توحيد الناس ليكونوا امة واحدة وما ينطوي عليه من حقيقة وحدة البشر تحت حكم اله واحد مطاع وعن حقيقة خصوصية الاديان التي جاء بها الانبياء، وعن حقيقة أهمية كتبهم الموحى بها من الله لحل الخلافات التي تمنع الناس ليكونوا امة واحدة، وهذه إشارة واضحة من القرآن الكريم على حقيقة التعددية الدينية لتتكامل الحياة، فالإسلام لم ينكر يوما حق أصحاب الديانات الأخرى في الحق بالحياة الكريمة والسعيدة داخل مجتمع يضم المختلفين من أجل تحقيق تفاهم وحوار وتعايش سليم يحفظ حق الاخرين في الاختيار والعيش الكريم، وهذا سر من أسرار أية تجربة ديمقراطية تريد لنفسها النجاح.
وإن القرآن وانطلاقاً من قوله تعالى: (لا إكراه في الدين) لا يتدخل في الإيمان الخاص بالأفراد غير المسلمين، وإن كان يحث على التعبد والتفكر بأمر العبادة ومآلاتها النافعة، إذ لا بد من خضوع البشر إلى قناعاتهم الداخلية واحترام هذه القناعات، ولا يريد الإسلام من هؤلاء الأفراد سوى إظهار الموادعة واحترام سبل العيش المشترك، وإذا ما قارنا هذا التعامل الأخلاقي مع تعامل الأوربيين لغير المسيحيين بعد استعادة بلاد الأندلس فأن البون شاسع بين التعاملين، فقد كان الاسلام أكثر وعيا بمشروعه الدنيوي الهادف إلى خلق حالة موادعة وسلم اجتماعي مادامت هناك حياة يسودها الاحترام، أما حفلات الإبادة الجماعية وحرق الأطفال والنساء وغيرها من السلوكيات التي ارتكبت في ما يعرف بمحاكم التفتيش ضد غير المسيحيين من مسلمين ويهود في أسبانيا قبل قرون، فهي سلوكيات لم يعرف لها المسلمون مثيلا في تاريخهم الطويل الذي عاش فيه النصارى بكنف المسلمين أخوة متحابين وأعضاء تتشارك لبناء جسد واحد.
ولعل سائل يسأل ماذا يقف وراء موقف الاسلام هذا؟ والإجابة تتعلق بموقف الإسلام نفسه من المؤمنين في الديانات الأخرى (اليهودية والاسلامية) إذ يؤكد القرآن الكريم في أكثر من موضع قدرة الناس على اختلاف أديانهم الثلاثة وتحت مبدأ التوحيد المتسامي بالإنسان على أن تحقيق مرضاة الله والفوز برضاه والنجاة بالقرب منه بغض النظر عن ديانته شريطة أن يكون مؤمنا بالله عاملا للصالحات مستقيما مع الناس سليم القلب، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) وهكذا فالاسلام يقدم نفسه جزءا من تجربة وَحْيانية كلّية لا تفرق بين نبي وآخر من أنبياء الديانات الابراهيمية ولا بين دين ودين، بل هو طريق مستقيم يوصل اللاحق بالسابق تحترم الأديان وتوصي بأهلها خيرا، وهذا ما لا نجده عند من يرى في جماعته أبناء لله دون سواهم، أو من يرون أنفسهم شعب الله المختار، ومن سواهم لا يستحقون الحياة والموت خير لهم.
وهكذا يظهر أن دينا عظيما كالإسلام جعل (تقوى الله) معيارا للتفاضل بين الناس لا القبلية ولا التراتب الاجتماعي أو الموقع المهم، لا يمكن ان يكون ديناً إقصائياً يلغي الآخر وينكر عليه وجوده، هو دين يقرّ بمدنية المجتمع ويسعى لترصينه من خلال استيعاب مفهوم التعددية التي تعد مرتكزا للديمقراطية الحديثة، أما ما تقوم به الحركات المتطرفة التي تدعي انتماءها للاسلام وتعادي كل ما هو غير إسلامي فهي حركات لم تفهم الجوهر العميق لهذا الدين الذي كان له قصب السبق في الوصول إلى عمق الجوهر الديمقراطي قبل أن تطبقه أوربا في العصور الحديثة، وإن إخفاق تجارب الحكم في البلاد الإسلامية لا يعني خطل الفكرة، وإنما يعني أن هناك خللا ما في بنية حياة الجماعة ووعيها المشترك وعلينا جميعا تقع مسؤولية كشف هذا الخلل وإصلاحه.