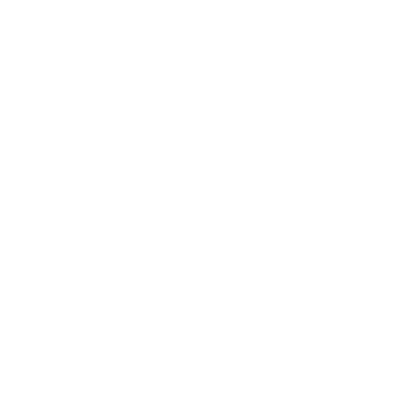الشورى في الحكم

حسن الهاشمي
بنظرة فاحصة لما يجري لنا من مصائب وكوارث وانفجارات أسبابها صراع محموم بين إرادتين متضادتين في الاتجاه والسلوك والنتائج، إرادة حرة يتطلع الشعب إزاءها لتحقيق معطيات الكرامة والتطور والإنعتاق وإرادة قمعية يتطلع إزاءها الحاكم المستبد لتكريس موجبات التحكم بمصير العباد والبلاد ولو بالبطش والقوة...
قبل كل شيء لابد من اجتثاث جذور الاستبداد من أنفسنا، وليس للحاكم حق الديكتاتورية مطلقاً، وكل حاكم يستبد فانه يعزل عن منصبه تلقائياً في نظر الأنظمة الديمقراطية، لأن العدالة من شرط الحاكم، والاستبداد الذي معناه التصرف خارج النطاق الديمقراطي أو خارج نطاق رضا الأمة، أي تصرف الحاكم في شؤونها الخاصة، هذا ظلم مسقط له عن العدالة، فالظالم الذي من طبيعته الظلم يتوغل في جرمه وجريرته من غير فرق بين المظلومين، سواء أكانوا من شعبه أم من شعوب أخرى، والإيغال في الظلم والتجبر هو الذي يوصل الإنسان إلى مهاوي الاستبداد وإلغاء الآخر، وليس شوائبه المتعلقة في نفوس كل واحد منّا، التي يمكن ترويضها ومعالجتها بالرياضات الانفتاحية.
الظلم من شيم النفوس فإن تجد
ذا عفـــــــــــــة فلعلة لا يــظلم
وفي المثل أن عجلة الديكتاتورية إذا تحركت تسحق حتى أقرب المقربين إلى الديكتاتور، ومن أعجب بنفسه هلك، ومن أعجب برأيه هلك، وأن عيسى بن مريم(عليه السلام) قال: داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله، وعالجت الموتى فأحييتهم بإذن الله، وعالجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه، فقيل يا روح الله وما الأحمق؟ قال المعجب برأيه ونفسه، الذي يرى الفضل كله له لا عليه، ويوجب الحق كله لنفسه ولا يوجب عليها حقا، فذاك الأحمق الذي لا حيلة في مداواته.
وأهم ميزة يمتاز بها الديكتاتور هي استهانته بعقول وأفكار الآخرين، بخلاف الحاكم الذي يستشير، فانه يعطي الآخرين من عقله ويأخذ من عقولهم، ويقلب آراءهم وينتخب الأصلح منها، لعله يكون فيه أنجع الدواء في معالجة المشاكل، ولهذا السبب حذر الإمام علي (عليه السلام) من مغبة الاستبداد بالرأي ورغّب في المشاورة بقوله (من استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقولها) وكذلك قال – عليه السلام- (مكتوب في التوراة...ومن لم يستشر يندم).
ولكي لا نقع في شباك الهلكة أو الندامة فلا مناص من أن تتحول الاستشارة إلى ثقافة متداولة بين الأفراد والأسر، وانه من الصواب أن يستشير الفرد جميع الذين من حوله من صغير وكبير وزوجة وأخوة وأخوات... ولا يمكن أن يستغني أحد عن الاستشارة مهما بلغ من الذكاء الخارق والفكر الوقاد، فالنبي(صلى الله عليه وآله وسلم) رغم انه كان يملك- بغض النظر عن الوحي الإلهي- قدرة فكرية كبيرة تؤهله لتسيير الأمور وتصريفها دون حاجة إلى مشاورة احد، إلا انه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يسعى لتعريف المسلمين بأهمية المشاورة وفوائدها ليتخذوها ركنا أساسيا في برامجهم، ولكي ينمي فيهم قواهم العقلية والفكرية كي لا تتغلغل الى اليهم روح الدعة والخمول والاتكال على عقول الغير، ويمكن القول بان هذا الأمر كان احد العوامل المؤثرة وراء نجاح الرسول الأكرم في تحقيق أهدافه الإسلامية العليا.
ومن هذا المنطلق فان الحكام والسلاطين أحوج ما يكونون لمشاورة أهل الرأي والاختصاص، لأنهم يتحكمون بالعباد والبلاد، كما لا بد من توفر موجبات الحكم من التقوى والصلاح والعلم والعدالة والإنصاف، فضلا عن تفويض العباد له، لأن الحاكم إنما يكون وكيلا عنهم في تمشية أمورهم الخاصة والعامة، والوكيل لا يمكن أن يحيد عن موكله، ما دامت المطالبات تصب في خانة القوانين التي تجلب على الإنسانية جمعاء السعادة والرخاء.
وها هو القرآن الكريم يحض على استعمال المشورة في أدنى الأعمال، كإرضاع الولد وفطامه، ولم يبح لأحد الوالدين الاستبداد بذلك دون الآخر، بقوله تعالى( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) (سورة البقرة- آية233).
فما بالك بأجلّ الأعمال خطرا وأعظمها فائدة، وهي قيادة الأمة وتقرير مصيرها! فهل بعد هذا من شك في حاجة الملوك والأمراء والرؤساء الركون إلى المشورة في تربية الأمم وتدبير شؤونها نحو الأحسن والأفضل وفي شتى مجالات الحياة؟!(1)
ومادام العقل يهتف بنا قائلاً: من استبد برأيه هلك، فلنعمل على قلع جذور الاستبداد من أعماق ذواتنا قبل أن نستأثر بالحكم والمنصب، فان الملك عقيم، وإذا ما تعلقت شوائب الاستبداد في قلوبنا وتبوأنا مركزاً سلطوياً في المجتمع، فسنرتكب الموبقات والجرائم والآثام، وبمرور الزمن سنلغي حق الآخرين حتى في التنفس وسنشك في أنهم بشر مثلنا! مثلما ارتكب الطغاة على مر العصور الغابرة.
وعلى هذا فالنظام الديمقراطي الحقيقي يختلف عما هو موجود حاليا في الدول الغربية الديمقراطية والتي تجري فيها الانتخابات وهي غالبا مجيرة، حيث أن المال المجتمع في أيدي القلة، يجمع حول نفسه الجماعات الضاغطة والإعلام والضمائر المشتراة، وبذلك يكون الحكم بيد من يريده رأس المال لا بيد من يريده الشعب، وهذه ديكتاتورية مغلفة بغلاف من الديمقراطية والحرية، وتكون النتيجة الاستبداد، لكنه مشوب بشيء من الحرية الصورية، ولا علاج للشعب في مثل هذه الحكومات إلاّ أن يراقب عدم تجمع المال، وإنما ينتفي(التجمع) إذا كان المال في قبال خمسة أشياء فحسب (العمل الجسدي، والعمل الفكري، وشرائط الزمان والمكان، والعلاقات الاجتماعية، والمواد الأصلية) وحينذاك يكون المال بيد الكل، كل بقدر حقه الطبيعي، وليس هناك تجمع غير مشروع للمال، ولذلك لا يكون للمال قبضة على الإعلام والجماعات الضاغطة والضمائر، ويكون الدور لإرادة الشعب في من ينتخبه.
أما الدول العربية والإسلامية التي فيها مجالس الشعب، والأنظمة الملكية التي بجانبها سلطة تمثيلية أو تنصيبية، أو المجالس التشريعية والتنفيذية والقضائية في زماننا الحاضر، فهي غنية عن التعريف، إذ أن معظم هذه المجالس- إلا ما خرج بالدليل- ما هي إلا بيارق يتلاعب بها السلطان المستبد كيفما يشاء، فهي لا حول لها ولا قوة، بل أنها تردد كالببغاء ما يقوله الحاكم!! وفلسفة وجودها مردّه إلى يقظة الشعوب الحقيقية، التي أضحت تخيف الحكام المستبدين، فعمد هؤلاء الحكام إلى التظاهر بان الحكم للشعب، وفي الحقيقة أن الشعب بعيد كل البعد عما يخطط ويجرى باسمه، أين هذه المؤسسات من قانون كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟!، وأين هذه المجالس من مبدأ الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يشمل جميع المسلمين!؟ وأين هذه اللجان من مبدأ اشراك الأمة في اتخاذ القرار، وصيانة الحاكم من الانحراف؟!.
وإذا ما طالب المرء بحقه، ومارس الشورى في حياته، سيتولد عندنا وبمرور الزمن مجتمع صالح رشيد، تكون عاداته وتقاليده كلها صالحة، وستنبثق تبعا لذلك سلسلة متراصة من الخير والصلاح والإصلاح، وستولد مؤسسات مجتمع مدني ولجانا استشارية وتعاونيات وأحزابا وصحافة حرة، تراقب الحكام والمسؤولين على أن لا يحيدوا عن جادة الصواب، أما في المجتمع الذي يقوم على أساس العقلية الضيقة، وعلى أساس الأنانية والسلوك المنفرد، وفي غيبة الشورى والحرية ستنمو في ذلك المجتمع بذرة الانحطاط والإسفاف والذلة مما يؤدي إلى حالة الانتقام التي ستستفحل بين أفراده، وانه لا يتحمل أية عادات أو تقاليد مغايرة لطريقته وسلوكه في الحياة، لذا تراه يلجأ إلى الانتقام، وهذا سيؤدي إلى سلسلة طويلة من حالة الفوضى والحقد والضغينة قد تسود ذلك المجتمع، بخلاف المجتمع الصالح الذي يقوم على أساس النصح والتسامح، فانه قد يرتكب أفراده خطأ ما، ولكنه لا يتحول إلى حالة من الحقد والانتقام وإنما يمتص ذلك الخطأ، ويسامح مرتكبه، وتقال عثرته وتغفر زلته.
وعلى هذا فالاستشارة ليست أمرا تجميليا أو زائدا عن حياتنا اليومية، بل أنها حالة طبيعية حضارية، تستسيغها الفطرة الإنسانية، بل وتحبذها على ما سواها، لأنها مدعاة لتطور الإنسان، وتفتق عقله وإبداعه، وبالتالي سيؤدي إلى رقيه ورفعته في كل شؤون الحياة، علاوة على ما ذكر فان الاستشارة تعطي ثمارها سريعا حينما تصبح جزءا من العمل والإجراء والتطبيق، كما الملح حينما يعطي تأثيره في الطعام.
أما الديكتاتورية فإنها إذا ما عشعشت فمن شأنها أن تلغي العقول، وتحكم العقل الأوحد، ولا ضير أن يستشير الحاكم المستبد، ولكن استشارته تكون منصبة لدعم حكمه وسلطانه، وليس لصالح المجتمع وتطوره، وهذا ما يخلق وضعاً كارثياً لا يعرف مدياته إلاّ من اكتوى بناره وسحق تحت حوافره، ولازلنا نحن شعوب العالم الثالث نئن تحت وطأة الإستبداد في الحكم الذي يسخر العباد والبلاد من أجل خدمة الزعيم أو الحاكم أو الملك أو الأمير ... إلخ تعددت الأسماء والهدف واحد وهو تبديد الثروات وتسخير الإمكانات لتقوية حكمه وسلطانه ونزواته الشخصية، وما الكوارث والمظالم والمآثم التي تترى علينا من كل حدب وصوب إلا نتاج الأنظمة الديكتاتورية التي ابتلينا بها فهي وبال على المجتمعات الإنسانية تقتل فيها روح الإبداع والتطور والحياة، ولهذا جاء الرفض القاطع من قبل العقل السليم- لكل أشكال الاستبداد مهما كانت مسوغاته ومهما كانت تبريراته ودوافعه.
ومن الغريب في الأمر إن الدول المستبدة قامت بتصدير النظام الشمولي للشعوب المغلوبة على أمرها ليس بالإقناع وحسن السيرة ولا بالانتخاب والاقتراع وإنما بالدم ورائحة البارود، حقا إنها ديكتاتورية من نوع فريد تقتحم الشعوب من دون استئذان يمكن تسميتها في عالم الغرائب بـ (عولمة الديكتاتورية!!).
(1) مجلة الروضة الحسينية/ العدد 23