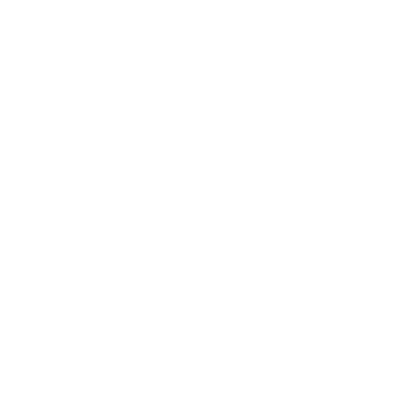قداسة الرسول الأكرم محمد (ص) في الضمير الإسلامي

د. علي ياسين
لعل السؤال الذي ظل يتردد طويلا بين الناس ومنذ قرون هو: ما سر كل هذا التقديس الذي تتوارثه أجيال المسلمين لشخصية إنسان عاش فبل قرون طويلة وفي بيئة مختلفة عن بيئتنا اليوم، وربما يتوسع السؤال فيكون ما هي المزايا التي جعلت من شخصية الرسول الأكرم خالدة وتزداد بريقا كلما مرت العصور وتقادمت السنون؟
لقد عاش الرسول الأكرم محمّد (صلى الله عليه وآله) حياة البداوة البسيطة التي كان عليها قومه في مطلع صباه، بينما منّت عليه السماء بحليب حليمة السعديّة بعد جفاف ثدي أمه، وهو طفل رضيع، وقد أحاطته عناية السماء فشرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، وطرح البركة بين يديه طفلًا ويافعًا يرعى الغنم فتدر ضروعها، وتلد مكثارة لا كما تفعل كلّ الأغنام.
ومما عزّز منزلته في مكة أن أهلها لقبّوه (الصادق الأمين) الذي لم يكن كشباب مكة –آنذاك- شارباً للخمر مقبلاً على اللهو. وبينما كان هذا الشاب الشريف في قومه والغريب معًا يسير في أزقة مكة وأسواقها، فيسمع الكذب الذي تنثره أفواه الباعة والتجار؛ فإنه يرتعد من قسوة الناس، ومن هوان الصدق والحق، فيقاوم كلّ ذلك الزيف بما يستطيع من قوة، ومن تعبير حي يجود به لسان فصيح، وتتلألأ به عين يشع منها سؤال كبير مفاده: ما قيمة الدنيا بلا صدق؟ وما أهمية الوجود بلا أمانة؟ وما فائدة البقاء بلا نبل وتضحية.
لكن الرسول الأكرم محمّداً من دون الناس كان مع كل هذا مهموما دائم الحزن، فهو لا يشعر بانجذاب إلى الآلهة التي يتقرب إليها قومه فيسجدون لها، ويذبحون وينذرون، ويسكرون تحت نصبها جهارا، ولا يأنفون من غزو ومن سلب ومن قتل للإناث الضعيفات، وكان هذا الواقع المأساوي المظلم يدفع به كلما سنحت الفرصة إلى ذلك الغار القصي في الجبل البعيد، حيث التجرّد من كل شيء وحيث الفراغ الذي يجعل الروح تنصت إلى كل نأمة تهمس بها هذه الجبال التي كأنها تريد أن تفصح له عن ماهيّته التي ما زال حتى اللحظة لا يدركها.
ويصل النبي محمّد (صلى الله عليه وآله) إلى زوجه الحانية الرؤوم كأمه مرتجفًا قائلًا لها:(زملوني، زملوني)إنه البرد الذي يعقب التحول العظيم، من الرجل الذي يأكل الطعام ويمشي بالأسواق إلى الرجل الذي ينزل عليه خبر السماء في الصباح والمساء" وتقصّ خديجة المدركة لما يشغل بال زوجها خبره على ورقة بن نوفل، فينتفض ورقة قائلاً: "قدوس قدوس، والذي نفسي بيده لئن كنت صدقت يا خديجة، فلقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة، ومع الأيام صارت النبوة جزءاً لا يتجزأ من الرسول الأكرم محمّد، وصار المستضعفون والفقراء والمظلومون والمضطهدون من أنصاره ومريديه، بينما عاداه سادة القوم وأصحاب الأموال، وكل من رأى في هذا الذي يدعو إليه هذا الرجل العظيم تهديداً لوجوده ومصالحه ومركزه الاجتماعي. ولما كانت النبوة ماهية مقدسة تتعالى على العادي والبشري، فالنبيّ هو –إذن- حامل الوحي، وهو الوسيط الذي يلتقي عنده المقدس بالعادي، ويقول ابن سينا في هذا الخصوص: (وأفضل الناس من استكملت نفسه عقلاً بالفعل، ومحصلاً للأخلاق التي تكون فضائل علمية، وأفضل هؤلاء، هو المستعد لرتبة النبوة، وهو الذي في قواه النفسية خصائص ثلاث هي: أن يسمع كلام الله، ويرى ملائكته، وقد تحولت له على صورة من الصور فيراه).وعليه، فقد كان منطلق النبي الأكرم بعد بعثته منطلقًا أخلاقيًا يهتم بمظاهر السلوك الاجتماعي كالحثّ على المساواة وإطعام اليتيم ورعايته، وإنصاف المظلومين والمحرومين بغض النظر عن جنسهم وانتمائهم، ثم تصاعد هذا المنطلق وتسامى ليتحول إلى ما يهدد قريش ومركزيتها من خلال الدعوة إلى التوحيد وهجر عبادة الأصنام التي أصبحت على رأس مكارم الأخلاق حيث جاء الإسلام ليتممها على أحسن وجه، مثلما كانت سبباً مباشراً لكل هذا البغض والكراهية التي قابلته بها قريش لثنيه عن مراميه وأهدافه.
إن هذا المسعى نحو المنطلق الإلهي النبيل لم يكن سهلاً بالمرة، ولكي تتكلل التجربة بالنجاح؛ كان لا بد لصاحبه من شجاعة فريدة، ومن قلب لا يعرف الجبن ولا التخاذل مهما كانت النتائج، ولا أدلّ من ذلك على رسائله إلى هرقل وكسرى وغيرهما، وهما –آنذاك- على رأس أقوى دول عصره يدعوهما إلى التوحيد وإلى الدخول في دين الله! لقد كان النبي الأكرم محمّد مثالاً فريداً في الحكمة والشجاعة والإقدام حتى أن أشجع العرب قاطبة باعتراف الأعداء أنفسهم، وهو ابن عمه وربيبه علي بن أبي طالب حامل ذا الفقار ومجندل الفرسان في سوح الوغى كان يقول واصفا شجاعة ابن عمه المنقطعة النظير:( كنا إذا احمرّ البأس، ولقي القومُ القومَ؛ اتّقينا برسول الله).
ومع كل هذه الشجاعة والصبر على المكاره، وقوة الشخصية فقد كان النبي الأكرم يعيش مع أصحابه واحدا منهم، وكأنه أبٌ لهم، أو قائد ملهم تقع عليه مسؤولية رعايتهم وإسعادهم. فالروح القيادية كانت من ضمن صفات شخصية محمّد، حيثُ كان -كما يذكر العقاد- على اجتنابه العدوان (يحسن من فنون الحرب مالم يكن يحسنه المعتدون عليه أنفسهم، إذ لم يجتنب الهجوم والمبادأة بالقتال لعجز وخوف مما يجهله ولا يجيده .. ولكنه اجتنبه لأنه نظر إلى الحرب نظرته إلى ضرورة بغيضة يلجأ إليها ولا حيلة له في اجتنابها حيثما تيسرت له الحيلة الناجحة).
إن هذه الانتصارات المتلاحقة لم تأت اعتباطاً، وإن تحويل القبائل التي كانت بالأمس ينهشها البغي والعدوان والتصارع فيما بينها إلى أمة تصنع التاريخ لم يكن من باب الحظ أو المصادفة، بل جاءت لأن الذكاء الإنساني والوحي الإلهي يعملان جنباً إلى جنب في توافق دائم، وخلافاً لأنبياء كثيرين سابقين، فإن النبي الأكرم محمّدا -كما يعبر أحد المستشرقين الكبار- لم يأت بأمل جديد للناس من قومه فحسب، بل(اضطلع بمهمة خلاص المجتمع الإنساني وإقامة مجتمع عادل يمكّن البشر من الرجال والنساء من تحقيق إمكانيّاتهم الفعلية، وأصبح للانتصار السياسي منزلة تشابه منزلة القربان المقدس عند المسيحيين، فقد كان آية للحضور الإلهي غير المرئي وسطهم، وهكذا فقد كان على النشاطات السياسية أن تستقر كمسؤولية مقدّسة، وأصبح النجاح اللاحق للإمبراطورية الإسلامية آية على أنه بالإمكان خلاص البشريّة جمعاء).
وعليه فإن الرسول الأكرم جعل لهذه الأمة وجودا جوهريا مختلفا من خلال تبليغه لرسالة الإسلام كدين عالمي يدعو الى العدل والاحسان والفضيلة ولإحياء الأنسان حياة المسؤولية الهادفة لا حياة التحلل والانحدار، وإن تقديس هذه الشخصية في ضميرها الأنساني هو جزء من محافظة هذه الأمة على شخصيتها وهويتها ووجودها الكلاني.