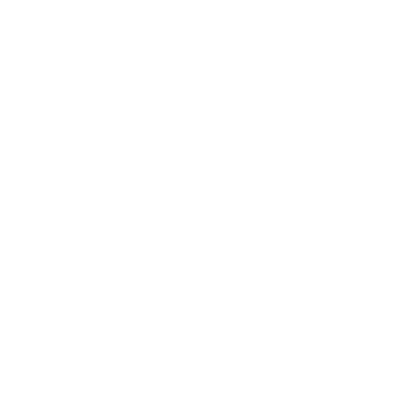الرحمة في المنظور الإسلامي: الإمام الحسين (عليه السلام) إنموذجاً

بقلم / نورا كاصد العبودي
إن الرحمة هو مبدأ من مبادئ الدين الإسلامي الذي يجب على كل مسلم الالتزام به، والتي نستطيع أن نصفها برقة القلب وحساسية الضمير، والشعور المرهف، وبالتالي هي التي تولد لنا الرأفة بالآخرين، والتألم لهم، والعطف عليهم، وكفكفة دموع الحزن وآلالم التي تعتريهم، والأخذ بيدهم ومساعدتهم وتخطيهم الصعاب التي يواجهونها.. وكذلك نجد مفهوم الرحمة يهيب بالمؤمن أن ينفر من الإيذاء وينبو عن الجريمة، حتى يصبح بذلك مصدر للخير والبر والسلام للناس أجمع.
وقد جاء ذكر لفظ «رحم» ومشتقاته ثلاثمائة مرة في القرآن الكريم، الأمر الذي يدل على اتساع المساحة التي تشغلها الرحمة في الحياة الدينية والإنسانية والإجتماعية.
وأتضحت أهمية الرحمة عندما وصف الله (سبحانه وتعالى)، بها نفسه فهو الرحمن الرحيم، الذي وسعت رحمته كل خلقه.. فقال في محكم كتابه العزيز (الرحمن الرحيم) الفاتحة.
فرحمة الله (جل جلاله) تشمل جميع ماخلق.
وفي الكافي، و التوحيد، و المعاني، و تفسير العياشي، عن الصادق عليه السلام في حديث :
و الله : إله كل شيء .
الرحمن : بجميع خلقه .
الرحيم : بالمؤمنين خاصة .
و روي عن الصادق عليه السلام :
الرحمن : اسم خاص بصفة عامة .
و الرحيم : اسم عام بصفة خاصة .
أقول : قد ظهر مما مر ، وجه :
عموم : الرحمن ، للمؤمن و الكافر .
و اختصاص : الرحيم ، بالمؤمن .
و أما كون :
الرحمن : اسما خاصا بصفة عامة .
و الرحيم : اسما عاما بصفة خاصة .
فكأنه يريد به : أن الرحمن خاص بالدنيا ، و يعم الكافر و المؤمن .
و الرحيم : عام للدنيا و الآخرة ، و يخص المؤمنين .
و بعبارة أخرى :
الرحمن: يختص بالإفاضة التكوينية ، التي يعم المؤمن و الكافر .
و الرحيم : يعم التكوين و التشريع ، الذي بابه باب الهداية و السعادة .
و يختص : بالمؤمنين ، لأن الثبات و البقاء ، يختص بالنعم التي تفاض عليهم ، و العاقبة للتقوى .
أرسل الله (عز وجل) نبيه محمد (صلى الله عليه وآله)، برسالة تسمو بالقيم والمبادئ العظيمة، والجليلة القدر..
حيث كان النبي محمد (صلى الله عليه وآله)، بمثابة رحمة للعالمين حيث قال الله (جل جلاله)، في كتابه المبين: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) الأنبياء (107).
وفي تفسير هذه الآية الكريمة ورد في الامثل في تفسير كتاب الله المنزل الجزء العاشر (إنّ الرحمة تسع عامّة البشر في الدنيا، سواء الكافر منهم والمؤمن، مشمولون لرحمتك، لأنّك تكفّلت بنشر الدين الذي يُنقذ الجميع، فإذا كان جماعة قد انتفعوا به وآخرون لم ينتفعوا، فإنّ ذلك يتعلّق بهم أنفسهم، ولا يخدش في عموميّة الرحمة.
وهذا يشبه تماماً أن يؤسّس جماعة مستشفى مجّهزة لعلاج كلّ الأمراض، وفيها الأطباء المهرة، وأنواع الأدوية، ويفتحوا أبوابها بوجه كلّ الناس بدون تمييز، أليست هذه المستشفى رحمة لكلّ أفراد المجتمع؟ فإذا إمتنع بعض المرضى العنودين من قبول هذا الفيض العام، فسوف لا يؤثّر في كون تلك المستشفى عامّة. وبتعبير آخر فإنّ كون وجود النّبي رحمة للعالمين له صفة المقتضى وفاعلية الفاعل، ومن المسلّم أنّ فعلية النتيجة لها علاقة بقابلية القابل.
إنّ التعبير بـ «العالمين» له إطار واسع يشمل كلّ البشر وعلى إمتداد الإعصار والقرون، ولهذا يعتبرون هذه الآية إشارة إلى خاتمية نبي الإسلام، لأنّ وجوده رحمة وإمام وقدوة لكلّ الناس إلى نهاية الدنيا، حتّى أنّ هذه الرحمة تشمل الملائكة أيضاً:
ففي حديث شريف مروي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) يؤيّد هذه العمومية، إذ نلاحظ فيه إنّ هذه الآية لمّا نزلت سأل النّبي جبرئيل فقال: «هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟» فقال جبريل: «نعم إنّي كنت أخشى عاقبة الأمر، فآمنت بك لمّا أثنى الله عليّ بقوله: عند ذي العرش مكين».
إن الرحمة التي زرعها الله (عز وجل) في النبي(صلى الله عليه وآله) أتت أُكلها عندما نمت في المؤمنين وبالأخص في بيت آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، وقد تجلت الرحمة الإلهية في قلب الإمام الحسين (عليه السلام)، سبط الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، حيث نلحظ هذه الرحمة تمركزت في كل مكنونات حياته لاسيما بتعامله مع آل بيته وأصحابه يوم العاشر من محرم، فامتاز صاحب الحق ذلك اليوم بالمعنويات العالية، ومصدر هذه المعنويات هو علاقته الوطيدة بربه (جل علاه)، فكلما قويت هذه العلاقة ازداد إيمانه بقضاء الله (سبحانه)، والتسليم له وارتفع في مدارك الكمال الإنساني وأزداد وأرتقى برحمته حتى وصل هذا المصاف هو وأصحابه وأخوته (عليهم السلام)، فالرحمة التي أودعها الله في الإمام (عليه السلام)، هي من أجمل العواطف الإنسانية وأنبلها وأعمقها أثراً، وهي منطلق كل خير بكل تجلياتها وامتداداتها كانت تمثل المنهج الذي سار عليه الرسول (صلى الله عليه وآله)، بأمر من الله (سبحانه)، ومن أعظم المواقف التي سجلها لنا التاريخ في معركة الطف حيث كان حب الله ورحمته (سبحانه وتعالى)، يملأن قلب الحسين (عليه السلام)،ولا يتركان مجالا للحقد وغيره حتى مع أعداءه حيث كان يدعو لهم بالهداية ومعرفة طريق الحق والانضمام إليه فكان يقبلهم بكل ما هم عليه لأنه يخاف عليهم من عذاب النار ومغبة جرأتهم على سبط رسولهم (صلى الله عليه وآله)، وقتله وسفكهم دمه الطاهر، وهذا ما عنه علي(ع): "فو الله ما وقعت الحرب يوماً إلاّ وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي وتعشو إلى ضوئي وذلك أحب إليّ من أن أقاتلها على ضلالها وإن كانت تبوء بآثامها"
اما ليلة العاشر من محرم تجلت أعظم صور الرحمة عند الإمام الحسين (عليه السلام)، فوصفت رواية معسكر الإمام الحسين عليه السلام في تلك الليلة بالقول: «بات الحسين عليه السلام وأصحابه تلك الليلة ليلة العاشر من المحرم ولهم دوي كدوي النحل، ما بين راكع وساجد، وقائم وقاعد».
وفي تلك الليلة جمع الإمام عليه السلام أصحابه وأهل بيته قائلاً بعد أن أذِنَ لهم بالانفصال عنه والتفرّق في البلدان لكي ينجوا من القتل: «ألا وإنّي لأظنّ يومنا من هؤلاء الأعداء غداً، ألا وإنّي قد أذنتُ لكم جميعاً، فانطلقوا في حِلٍّ ليس عليكم منّي حرج ولا ذمام، وهذا الليل قد غَشيكم فاتّخذوهُ جَمَلاً، ثمّ ليأخذ كلّ رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرّقوا في سواد هذا الليل، وذَروني وهؤلاء القوم؛ فإنّهم لا يريدون غيري، ولو أصابوني لذُهلوا عن طلب غيري»، فرفضوا ولم يتفرّقوا وآثروا البقاء معه إلى النهاية، واستشهدوا جميعاً. وكان في مقدمة الرافضين العباس بن علي عليه السلام وإخوته وبقية شباب بني هاشم.
فما علينا ونحن نحيي هذه الأيام الحزينة أن نجرد قلوبنا من الحقد، والبغضاء، ونجعل الرحمة والتراحم منهاجا نسير عليه، كي نسير في قافلة النجاة مع الحسين وآله (عليهم السلام).