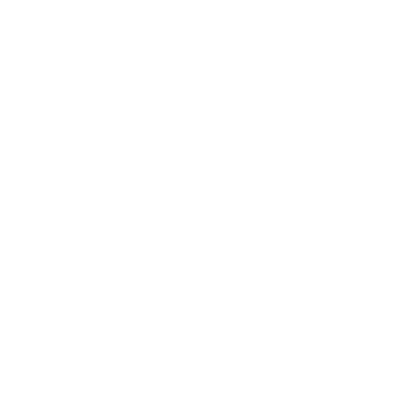الاسلام والأنثروبولوجيا

جلال عبد الحسن
إن مصطلح ( أنثربولوجيا ) يونانيّ الأصل، وهو مركّب من مقطعين هما: (أنثروس) و يعني إنسان، و(لوجيا) ويعني علم، وبهذا المعنى فإن الأنثروبولوجيا تشير إلى علم الإنسان، أو المعرفة المنظَّمة عن الإنسان.
ويربط علماء الاجتماع في العالم المتحضر ظهور هذا العلم بالغرب المعاصر تحديدا، وانطلاقا من أن مفهوم هذا العلم ينهض من خلال تركيزه في دراسته على الإنسان وعلى سلوكه، وتحديد أوجه الشبه والاختلاف بين الانسان وبين إنسان آخر خاضع لظروف مختلفة من جهة، ثم بين ذلك الانسان وبين الحيوانات - وخصوصا الثديّة منها - من جهة أخرى، وهو ما يعني أن اهتمام الإنثروبولوجيا بدراسة الإنسان الذي يعيش في مجتمعٍ ما أو في جماعاتٍ معروفة، وليس بدراسة الإنسان منفرداً، كما يهتم هذا العلم بدراسة أفكار ومعتقدات الإنسان ومستوى ثقافته وتطورها، بالاعتماد على نظريات التطور عبر الزمن الممتد والمتراكم.
وربما أخطأ كل من يحصر نطاق هذا العلم عند الأوربيين المعاصرين، لأن هذا العلم له أصوله في الفكر وفي التطبيق الإسلامي كما سيتضح لنا من هذا المقال الموجز، فضلاً عن أن جذور هذا العلم نجد صداها عند المؤرخ الإغريقي القديم (هيرودوتس ت400 ق.م) الذي يعد ((أبو الأنثربولوجيا)) لدقته العالية في وصف ظروف الأقوام والمجتمعات والبلدان التي زارها ولإجادته في وصف حالاتهم المعيشية، كقدماء المصريين وسكان ما بين النهرين وبلاد فارس والهنود وغيرهم من الأمم الأخرى التي تابعها من خلال رحلات استكشافية قام بها.
وبما أن الاسلام نظام كوني شامل له منظاره الخاص لكل جوانب الحياة الفردية والاجتماعية، فهو من الممكن أن يشكل من خلال هذا النظام نسقاً فكرياً له خصوصيته المميزة له، عن الأنظمة الكونية الكبرى التي اقترحها الإنسان كالماركسية والليبرالية مثلاً، وإن ما ينبع من هذا النسق من نظريات اجتماعية لا تكون بالنتيجة مرتهنة بالوصف والتحليل كما هو حال المدارس الغربية، وإنما ستدفع الباحث المؤمن برسالة الإسلام وانطلاقاً من التزامه ومسؤوليته الإنسانية التي تحث عليها نصوصه وتعاليمه المقدسة إلى اقتراح المعالجات والحلول التي يرصدها كانثربولوجي يهتم بدراسة الإنسان بوصفه فرداً ضمن مجتمع متحرك ومتغير باستمرار.
والإسلام إسوة بالأديان السماوية الأخرى ( اليهودية والمسيحية) يعد مخططاً (بفتح الطاء) للنظام الاجتماعي، وهذا المخطط مؤمناً بقواعد إلهية أبدية ومستقلة عن إرادة الإنسان، وقد انتقل لنا هذا المخطط عبر تراث مكوَّن من مجموعة خطابات تسعى لتعليم من يؤمن بالاسلام ديناً وعقيدة الشكل والهدف الصحيح لكل ممارسة افترضها الاسلام واكتسبت صحتها وسلامتها عبر مئات السنين من التاريخ الذي أسبغ عليها الثبات والاستقرار، أي أن هذه الخطابات ترتبط بماض معلوم ينفتح على مستقبل ممتد يحاول فيه مَن آمن بعقيدة الاسلام أن يحافظ على حدود ذلك المخطط كما أقرّه كتاب المسلمين وأحاديث نبيهم الأكرم الصحيحة السند.
ومعنى ذلك هذا التراث بتنوّعه وتعدد أوجهه هو تراث يوجه نفسه نحو مفاهيم الماضي ومفاهيم المستقبل فيما يخص الممارسات المتجددة بفعل التطور التاريخي الذي تشهده المجتمعات الاسلامية على اختلافها، إذ ليس كل ما يفعله ويقوله المسلمون اليوم ينتمي بالضرورة لذلك التراث، كما أنّ ممارسات اليوم ليست بالضرورة محاكاة لما مضى من ذلك التراث، ولذلك فقد أخطأ علماء الاجتماع مّمن أوّلَ التراث - انثربولوجياً - منهم على أنه وسيلة من وسائل الدفاع التي يقترحها الاسلام لمواجهة القوى المتربصة به للتحصن والخندقة داخل هذا المسمى الكبير (التراث)، فالمسلمون هم مسلمون سواء في تاريخهم القديم الممتد أو في اللحظة الراهنة، وما ممارساتهم اليوم إلا صورة من صورة التزامهم بتعاليم الاسلام وتقليد نموذجيته التي علمها رسول الله وأهل بيته الأطهار من بعده للأمة، ومدى تطبيق ذلك وشجب ورفض الممارسات الأخرى غير المتطابقة مع تلك التعاليم الرسالية.
لكن هل بقيت تلك التعاليم - على قدسيتها - بعيداً عن أيدي التغيير أو التحريف المتعمد أو التبدل العفوي أحيانا؟
إن الإجابة هنا تأخذ بعين الاعتبار التطور الكبير والتمدد الذي عرفه المجتمع الاسلامي بعد دخول الناس أفواجاً في هذا الدين برُقعة جغرافية لم تعد تقتصر على مكة والمدينة الحاضنتان الرئيسيتان لفكرة الاسلام كدين وكعقيدة ألهمها الله وحياً مقدساً على رسوله الأكرم، وإنما أصبحت تشمل هذه الرقعة الجغرافية الضخمة فضاءا واسعاً ممتداً من الصين شرقاً وحتى اسبانيا غرباً ومن روسيا شمالاً وحتى الصومال وأثيوبيا جنوباً.
إن هذه الرقعة الجغرافية التي تضمّ أجناساً بشرية شتّى توحي باستحالة تجانس التقاليد الاسلامية، ولكنها مع هذا فإنها توحي بإمكانية إنسجامها جميعاً، وهذا ما ستأخذه انثربولوجيا الاسلام على عاتقها في محاولاتها الحثيثة لفهم الظروف التاريخية التي أدّت إلى انتاج تقاليد (اسلامية) متنوعة والحفاظ عليها ومن ثم نقلها للأجيال، فضلاً عمّا يضطلع به هذا العلم (الانثربولوجيا) من تحليل جهود ممارسي هذه التقاليد من أجل معرفة العوامل البشرية الخاصة التي أسهمت في تحقيق هذا الانسجام بين المسلمين على اختلاف مشاربهم وأجناسهم البشرية.
ومما تقدم يمكن القول أن القضايا الانثربولوجية التي تزخر بها الحياة الاسلامية لم تأخذ حقها من الدرس والبحث والتحليل المعرفي، وإن ما ركّز عليه علماء الانثربولوجيا الغربيين ومن تأثر بأطروحاتهم من أبناء المسلمين هي دراسات مصبوغة بالكراهية المسبقة للاسلام والموقف غير العلمي والاخلاقي منه، من خلال تركيزها على الشاذ في هذه الحياة، كتسليطهم الضوء في دراساتهم مثلا: على دونية المرأة واحتقارها مقارنة بالرجل في المجتمعات الاسلامية، وكمسألة انتشار زواج ابنة العم في المجتمعات العربية المسلمة والتخريجات المضحكة لها، وكقضية سلطة زعماء وشيوخ القبائل وعدم خضوعهم للمساءلة القانونية عند ارتكابهم لجرائم الاعتداء على الآخرين بحجة الدفاع عن الشرف والفضيلة القبلية، وسوى ذلك من أمور أخرى هي في الحقيقة ليست من الاسلام بشيء، وقد تمارَس في مجتمعات أخرى غير إسلامية أيضاً.
ولم تأخذ هذه الدراسات جوانب أخرى مضيئة تزخر بها الحياة الثقافية للمسلمين على المستوى الانثربولوجي والاجتماعي، كاعتزاز الفرد المسلم بدينه وعدم قدرته نفسياً على التخلي عن هذا الدين حتى وهو يحيا بين جماعة لا تدين بالاسلام ولا تمارس طقوسه، وكشيوع الحنين الجارف للمسلمين المهاجرين لديارهم التي هاجروا منها واحساسهم بالاغتراب الروحي في بلدان المهجر الميسورة، رغم وجود العسف والاستبداد والتردي في ديارهم التي هجروها، وكشعور المسلم بالاطمئنان الروحي عند وجوده في أسواق المسلمين للتبضع، او لتناول الطعام، وكموقف الشباب المسلم من الزواج من غير المسلمات وما ينتج عن ذلك من نتائج اجتماعية قد تكون وخيمة، وكل هذه الأمور وغيرها بحاجة الى بحث واستقصاء على المستوى الاجتماعي، وهو ما يتوجب على علماء الانثربولوجيا من المسلمين الوقوف عنده طويلاً رداً لدَين هذا الدِين العظيم الذي أمدهم بكل هذا التنظيم المتناهي في دقته وترتيبه، وعدم الركون إلى نتائج علماء الغرب في تحليلهم الانثربولوجي للظواهر الاجتماعية في المجتمعات ذات الغالبية المسلمة، لأن هذه الدراسات مضللة وبعيدة عن الحقيقة وعن الواقع العلمي.