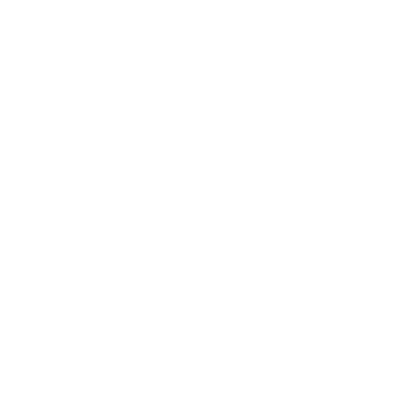الوحي والبعثة

الوحي والبعثة
الوحي في اللّغة هو الكلام الخفي، وهو الإشارة السريعة، أو هو إلقاء ما يريد الموحي إلقاءه لدى الطرف الآخر، من إعلام وأوامر وإرشادات... إلخ، سواء عن طريق الإشارة، أو الكتابة، أو الرمز، أو المحادثة. وقد اتّخذت كلمة (الوحي) معنىً اصطلاحياً قرآنيّاً كغيرها من الكلمات العربية، التي نُقِلَت من استعمالها العام إلى استعمالها الشرعي الخاص، فأصبح لفظ (الوحي) اسماً لِما يُلقى للأنبياء والرسل من كلام الله وقوله سبحانه.
قال الشيخ المفيد: "أصل الوحي هو الكلام الخفيّ، ثمّ قد يُطلق على كلّ شيء قصد به إلى إفهام المخاطَب على الستر له عن غيره، والتخصيص له به دون مَن سواه، وإذا أضيف إلى الله تعالى كان فيما يخص به الرّسل (ع) خاصة دون مَن سواهم على عُرف الإسلام، وشريعة النّبيّ".
ولقد كان الوحي الإلهي منذ بزوغ أنواره على سطح هذه الأرض، وإلى يومنا هذا، وسيبقى كذلك يشكِّل لدى الجاهليين مشكلة فكرية واعتقادية صعبة الفهم، عسيرة الاستيعاب.
أمّا بالنسبة للفكر الإيماني فليست ظاهرة الوحي لديه في حقيقتها إلّا التعبير عن استمرار العناية الإلهيّة الرحيمة، وتتابع الألطاف الربّانية الهادية، رحمة بالإنسان الضال المنحرف، وإنقاذاً له، إذ لم يشأ الله سبحانه أن يخلق الإنسان ويتركه مهملاً بلا توجيه، وضائعاً بلا رعاية على هذه الأرض، بل جعل الله الوحي إلى الإنسان وسيلة لتعريفه بنفسه، بربِّه، وعالمه، وسبيلاً إلى هدايته، لتنظيم حياته، وبيان طريقة تعامله مع أبناء نوعه، وكيفيّة توجّهه إلى خالقه.
وهكذا شاء لطف الله بعباده، وقضت إرادته الحكيمة أن يختار أفراداً مخصوصين ومؤهّلين للاتصال بالألطاف الربّانية بعد أن يهيئهم الله بلطفه، فيوفِّر لهم الاستعداد الروحي، والتكامل النفسي، والنضج العقلي، والسمو الذاتي، ليكونوا مؤهّلين لحمل الرسالة وتبليغ الأمانة، وتمثيل الإرادة الربّانية على هذه الأرض: (اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ).
(وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ).
وإذن لابدّ للنّبيّ من بلوغ نوع من الاستعداد، والتكامل الروحي الذي يهيِّئه لتلقِّي الفيض والمعرفة الإلهية، ويرفعه إلى درجة التجرّد عن هذا العالم المادِّي، والتعلّق بالله سبحانه.
وهاتان الصفتان: التجرّد والتعلّق، هما الوسيلتان الروحيتان لتمكين النبيّ من اختراق المألوف من عالم الشهادة، عالم الحسّ، والاتصال بعالم الغيب في حالة الوحي، حيث يتم تعطيل ارتباط الذات الواعية بالعالم المادي، ويحصل الانفصام الكلِّي عنه، لترتفع القوى الروحية والعقلية المتسامية إلى درجةٍ تجعل الذات النّبويّة في حالة روحية مستعدة لاستقبال ما يُلقى إليها من العالم العلوي ووعيه وإدراكه.
وهكذا تكون الذات النبويّة في حالة تلقِّي الوحي مطلّة على عالم التجليات العلوية، ومشدودة إلى إفاضة الأنوار القدسية، ومقتربة من حظائر القدس، وعالم الجلال، عبر انفصال مؤقّت عن عالم الشهادة – عالم الحس والمادّة – واختراق للمألوف من قوانينها.
وبالتأمل في النصوص والمفاهيم القرآنية والروايات التي تحدّثت عن الوحي والنبوّة نستطيع أن نشخِّص حالتين لتلقِّي الوحي من عالم القدس والجلال، وهما:
أ- التلقّي المباشر الذي عبّر عنه الإمام جعفر الصادق بقوله: "ذلك إذا لم يكن بينه وبين الله أحد".
ب- التلقّي عن طريق ملك الوحي – جبريل (ع) – حيث يتنزّل الأمر والوحي إلى عالم الملائكة التي تتلقّى من مكنون العلم في حظائر القدس ومحفوظ المعرفة والإرادة الإلهيّة، المُفاضة مِن لَدُنِ علّام الغيوب، ليتم نقله وتبليغه إلى النّبيّ الكريم محمّد (ص).
وقد تحدّث القرآن الكريم عن هذا اللّون من الإيصال والتلقّي، فقال: (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ).
(وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ).
وهكذا يُلقَى الوحيُ مِن لَدُنِ الذات الإلهيّة إلى عالم الملائكة ليهبطَ به جبريل على عالم الإنسان القائم في شخص النبيّ، وهو في حالة الإنسلال من عالم المادّة وانكشاف حجابها وانطلاق الوعي إلى عالم الروح الملائكي، فيتلقّى من الملَك ما يُوحى إليه من أمر ربّه.
على أنّ هذا الانتقال من عالم القدس إلى عالم الخُلق الملائكي، هو انتقال نوعي وذاتي، وليس انتقالاً زمانياً، أو مكانياً.
وهكذا كان الكلام الإلهي إلى الرسول الأعظم يأتي وحياً، أي إلقاءً مباشراً في نفس النّبيّ، أو من وراء حجاب، أو بواسطة ملك مرسل.
وهذا ما يقتضيه منطق السنن الكونية المسيطرة على الطبيعة الإنسانية: (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ).
ولا يدري أحد كيف يتم ذلك، فالكون عوالمه غريبة، وعالمنا ليس إلّا واحداً من تلك العوالم، ولكلِّ عالم قوانينه وأنظمته الخاصّة به، ولا ندري كيف تجري العوالم الأخرى، فهي أيضاً لها قوانينها وطبيعتها الخاصّة بها.
إلّا أنّنا نجد في وصف الإمام عليّ (ص) للعالم الملائكي، وعلاقته بالله من جهة، وبعالمنا من جهة أخرى ما يكشف لنا بعض جوانب الغموض، ويجلِّي بعض معالم الحقيقة.
قال (ع): "(وبينَ فَجواتِ تلكَ الفُروجِ زجل المسبِّحين منهم في حظائِر القُدس، وسُتُراتِ الحُجُبِ، وسُرادِقاتِ المجدِ، ووراءَ ذلك الرّجيج الذي تَسْتَكُّ منهُ الأسماعُ سُبحاتُ نورٍ تَردَعُ الأبصارَ عَن بلوغِها، فَتَقِفُ خاسِئَةً على حُدودِها...).
إلى أن قال: (جعلهم اللهُ فيما هنالك أهلَ الأمانةِ على وحيهِ، وحَمَّلَهُم إلى المرسلين ودائعَ أمْرِهِ ونَهْيِهِ وعَصَمَهُم مِن رَيْبِ الشُّبُهاتِ)".
تلقِّي الأنبياء(عليهم السلام)
يتلقّى الأنبياءُ والرّسل (ع) ما يريدُ الله سبحانه أن يُلقِيَهُ إليهم من أوامرَ ومعارفٍ وإرشاداتٍ وتشريعاتٍ بطرق ووسائل يمكن استقراؤها وحصرها في ما يلي:
أ- بواسطة الإلقاء في نفس النّبيّ، ووضوح المعنى لديه، كما يحصل في التسديد والتوجيهات العامّة للرسول (ص).
وقد ورد على لسانه (ص) ما يؤكّد هذه الحقيقة، ويكشف عن هذه الكيفية، كقوله: "يا أيُّها النّاس! إنّه قد نَفَثَ في رَوْعي روحُ القُدسِ، أنّه لن تموتَ نفسٌ حتّى تستوفيَ في رِزقَها".
وهذه الحالة من الوحي والتعليم، هي عبارة عن إيضاح وتسديد، ولكن مع علم النّبيّ أنّ الذي يلقي في نفسه هو روح القدس.
ب- الوحي المباشر، ويتمّ بواسطة الكلمة الإلهيّة التي يسمعها النّبيّ صوتاً، ويعيها معنىً، وليس بينهما أحد، وتحصل هذه الحالة من الوحي عن طريق إلقاء الكلمة الإلهيّة بلا واسطة ملك، إنّما يسمع النّبيّ وهو في وضعه المتهيِّئ لاستقبال الكلمة المُلقاة إليه، كما يسمع الأصوات الأخرى، ولكن عن طريق خلق أصوات ومعانٍ، وعبارات في وعي النّبيّ بصورة تتناسب وطبيعته الإنسانية، وتتفق مع استعداده الذاتي.
وقد تحدّث الإمام جعفر الصادق (ع) عن هذه الكيفية العليا من كيفيات الوحي فقال: " كان رسول الله إذا أتاهُ الوحيُ من الله وبينهما جبرئيلُ (ع) يقول: (هو ذا جبرئيل، وقال لي جبرئيل)، وإذا أتاه الوحي وليس بينهما جبرئيل تصيبه تلك السّبْتَةُ ويغشاهُ منه ما يغشاهُ لثقلِ الوحي عليه منَ الله عزّ وجلّ".
ج- الوحي بواسطة تكليم الملك جبرئيل (ع) للنبيّ واستماعه إلى ذلك كما يستمع لأيٍّ من الأصوات البشرية المعتادة، قال تعالى: (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ).
د- الإيحاء إلى النّبيّ بواسطة الرؤيا في المنام، كما في رؤيا إبراهيم (ع): (قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ).
وكما في رؤيا الرسول (ص) التي تحدّت عنها القرآن بقوله: (وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ). (لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ)
الإعداد للنّبوّة
أعدّ الله نبيّه محمّداً (ص) وهيّأه لحمل الرسالة، وأداء الأمانة الكبرى لإنقاذ البشرية، وحين بلغ الأربعين سنة من عمره الشريف، اختاره الله سبحانه نبيّاً ورسولاً وهادياً للبشرية جمعاء.
وكانت بداية الوحي، وقبل أن يأتيه جبريل (ع) في غار حِراء، أنّ رسول الله (ص) كان يرى في المنام الرّؤيا الصّادقة، وهي درجة من درجات الوحي، كما كان يذهب إلى غار حِراء يخلو فيه ويتعبّد.
فقد روي عن محمّد بن كعب وعائشة: أنّ أوّل ما بُدِئَ به رسول الله (ص) من الوحي، الرّؤيا الصّادقة، وكان يَرى الرّؤيا فتأتيه مثل فلق الصبح، ثمّ حُبِّبَ إليه الخلاءُ، (فكان يخلو بغار حِراء).
إنّ المتأمِّل في تلك الرواية يستطيع أن يفهم منها حقائق أساسية تتعلّق بالوحي والنّبوّة:
1- إنّ النّبيّ كان يُهيَّأُ من قِبَل الله تعالى لتلقِّي الوحي بتوجيهه عن طريق الإلهام والإلقاء في نفسه، والانكشاف له من خلال الرّؤيا الصّادقة، ولم يُفاجأ به، كما تُصوِّرُ بعضُ الأخبار ذلك.
وواضح أنّ رؤيا الأنبياء هي درجة من درجات الوحي، ولكنّها أقل مستوىً من التكليم بواسطة جبريل (ع).
2- تحبيب الخلوة له من قبل الله تعالى، لينقطع عن عالم الحس والشهادة، ويستغرق في التأمّل والتعالي نحو عالم الغيب والملكوت الأعلى، والاتّجاه إلى الله سبحانه، وليكون مُهَيّأً لتلقِّي الفيض الإلهي والوحي الربّاني.
وبذا فلم يكن النّبيّ (ص) ليذهب إلى غار حِراء ذهاباً عفوياً غيرَ مُوَجّهٍ، ولا حكمة فيه ولا انتظار؛ فالرّوايات تُصرِّح بأنّ النبي (ص) كان ينقطع في كلّ عام شهراً كاملاً في هذا الغار، للخَلْوة والانفراد.
كما كان يذهب في بعض الأيّام للخَلْوة والتأمّل هناك، وليس معقولاً أن يتمّ كلّ ذلك بصورة عفويّة، أو بدافع شخصي من الرسول، بل كان توجيهاً إلهيّاً، ومرحلة تأمّل وانتظاراً للوحي، وكان فيها على اتصال بعالم الملكوت الأعلى عن طريق الرؤيا والمنام.
نزول الوحي: وفي سنة (610م) وهي السنة التي أراد الله سبحانه أن يبعث نبيّه محمّداً (ص) إلى الناس كافّة، كان النّبيّ قد ذهب في شهر رمضان من تلك السنة، إلى الغار ومعه أهله مجاورون، فأتاه جبريل (ع) فألقى إليه كلمة الوحي، وأبلغه بأنّه نبي هذه البشرية والمبعوث إليها.
وتفيد الروايات أنّ أوّل آيات قرأها جبريل على محمّد (ص) هي: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ).
وتحدّث القسطلاني عن أوّل ما نزل من القرآن فقال: "وقد رُويَ أنّ جبريل (ع) أوّل ما نزل بالقرآن على النّبيّ (ص) أمره بالاستعاذة، كما رواه الإمام أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس قال: أوّل ما نزل جبريل على محمّد (ص) قال: يا محمّد استعِذْ، قال: (إستعِذْ بالسّميع العليمِ مِنَ الشّيطان الرّجيم)، ثمّ قال: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، ثمّ قال: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)".
بعد تلقِّيه ذلك البيان الإلهي، عاد النّبيّ إلى أهله، وهو يحمل كلمة الوحي، ومسؤولية حمل الأمانة التي كان ينتظر شرف التكليف بها، ويخلو زمناً في الغار لتلقِّيها.
وعاد فاضطجعَ في فراشه وتدثّر ليمنح نفسه قِسْطاً من الرّاحة والاسترخاء، فجاءه الوحي مرّة أخرى يأمره بالقيام، وترك الفراش والبدءِ بالدعوة والإنذار. جاء هذا الخطاب في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ * وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ * وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ).
المصدر: محمد رسول الله (ص)/ مؤسسة البلاغ